موضوع الدراسة إشكالية التدريس بالكفايات .مقاربة نجريبية على نص روائي أوراق لعبدالله العروي،
وقصيدة شعرية : نسر للشاعر عمر أبو ريشة
المصطفى ملاك
1- تقديم:
هناك علاقة قوية بين المنظومة الثقافية و التربوية من جهة, و بين المتغيرات المتسارعة التي تحدث من جهة أخرى على صعيد المحلية و العالمية. و من هذا المنطق, ارتبط المجال التربوي بالعلوم المجاورة له, و كذا بفلسفات و تصورات المجتمعات الإنسانية. و من خلال قراءة كرونولوجية سريعة, يظهر بوضوح تطور المعرفة التربوية ابتداء من التصور الفلسفي المثالي و الأخلاقي و الديني مع الغزالي و ابن سحنون و ابن جماعة و إخوان الصفا و العقلاني مع الفرابي إلى التصور البركماتي مع ابن خلدون. هذا على مستوى المجتمع العربي الإسلامي أما على مستوى الغرب, فهناك التصور المثالي مع روسو و كانط و ستوارت ميل مرورا بواقعية بيكون, و بركماتية جان ديوي, إلى التصور السوسيولوجي مع دوركايم و باسرون و التوسير, تم التصور السيكولوجي مع سكينر و ليتري و بافلوف, و انتهاء مع التصور التكنولوجي الصناعي مع رالف تايلر, إلى غاية التصور المعلوماتي المبني على المعرفة المجردة و الخبرة العلمية.
و خلال هذه الرحلة الطويلة ظهرت صنافات و تصنيفات و شبكات للتدريس و خطاطات ترسم المسار البيداغوجي في نقل و تمرير المعرفة الإنسانية. لكننا لاحظنا انقلابا كبيرا في الوضع المعرفي للتربية. فبعد أن سقطت أوروبا في مشاكل نفسية و مادية و أيديولوجية, لجأت إلى ربط التعليم بالمكننة و التكتيك الحربي. الشيء الذي أسقط تعليمها في النظرة التشييئية للإنسان و المعرفة الموجهة. و يكفي أن نشير إلى مثالين توضيحيين: تجديد فرنسا لنظامها التربوي في أعقاب حربها ضد الألمان, ثم عملية الإصلاح التي قامت بها أمريكا في أوائل الثمانينات لمنظومتها التربوية إبان دخول الاتحاد السوفياتي ميدان التصنيع الفضائي. و مع تغير خريطة العالم سياسيا و عسكريا فقد لوحظ سعي أمريكا إلى عولمة التربية تحت شعارات مزيفة مثل حقوق الإنسان و تحرير الاقتصاد و غيرها من المصطلحات المرتبطة بالاحتكار الثقافي لمنظومة العلاقات الدولية و التحكم في مصائر الشعوب الأخرى. فمنذ أوائل التسعينات وعت أوروبا هذه الإشكالية غيرت نظرتها إلى البنى الثقافية و التربوية و نظم التعليم. بحيث لم تعد الثقافة هي ذلك الركام المعلوماتي و إنما هي فن ممارسة الحياة. و من هذا المنطق ظهر في الحقل التربوي مصطلح الكفايات، و تزايد حجم الدعوة إلى تكامل المعرفة، عوض تلك النظرة الضيقة إلى الصنافات و مفاهيمها الضيقة التي تجزئ آليات الفعل البشري. و انطلاقا من هذه القناعة بأهمية الصيرورة التربوية, تغيرت النظرة إلى التربية و التعليم و التعلم في إطار متغيرات الحياة و ما يتطلبه تطور العلوم من بدائل جديدة.
و استرشادا بهذه المعطيات, فقد حصل تحول عميق في وظائف المدرسة كما تغيرت النظرة إلى المنظومة التربوية, و لم يعد مجال التدريس مقتصرا على تلك النظرة المتعصبة لصنافة معينة و إنما توجه الاهتمام إلى مفهوم الكفايات في بعدها الشمولي.
و من خلال نظرة سريعة في الخريطة التربوية على امتداد سنوات غير يسيرة, نتوقف عند ملاحظتين هامتين:
أ- المعرفة التربوية كصناعة مقننة بحاجات التصنيع الاقتصادي و الحربي
ب- المعرفة التربوية كمهارة من مهارات الثورة المعلوماتية الشاملة.
في المرحلة الأولى : نظر إلى المدرسة كمصنع و ما يرتبط به من مدخلات و مخرجات (1) و يمكن حصر هذه المرحلة زمنيا في الستينات حين لجأ الغرب إلى ربط التعليم بالمصانع في جانبها الحربي و التكنولوجي. ووقع التعامل مع المعرفة داخل المؤسسة بمثابة ورشة أو مقاولة. و داخل هذا الهيكل المادي المكون من عمال و مواد خام, طرح السؤال الإشكال: كيف يمكن أن نهيئ مشاريع تعليمية لمواجهة التطور الصناعي الذي اتخذ شكلا علميا عنيفا؟
في المرحلة الثانية: و مع ثورة عصر المعلومات ( التسعينات ) توسعت رقعة الخريطة المعرفية و خصوصا النظام التربوي, و بالتالي لم تعد المعرفة محكومة بالزمكان و الأدلجة, و بدأت عملية تحويل المصانع إلى ما يشبه المدارس. أي أن الغرب انتقل من التعلم بالمفهوم المدرسي إلى التعلمل بالمفهوم الصناعي(2).
و بتواز مع هذا التطور السريع في المعرفة ظهر مصطلح " كفاية" فبعد أن سيطرت فلسفة المكننة و التصنيع في الميدان التعليمي, مالت الكفة المعرفية نحو تصور تربوي جديد يطرح فهما جديدا لنظرية الاكتساب المعرفي. و يمكن توضيح هذا التحول المثير بالقول بأن التعليم انتقل من فكرة التقنين و التقنية الصناعية إلى استراتيجية التمهير في طابعه الشمولي و النسقي.
و تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الكفايات موضوع شائك من الناحية النظرية و العلمية. لأنه يعتبر نسبيا مستحدثا في الحقل التربوي. ثم إن جدته ليست مستقلة عن المكتسبات السابقة. بحيث أنه يمثل امتدادا و تطورا لتلك التفسيرات الصنافية من ناحية كما أنه يرفضها في نواحي أخرى. ثم إن التدريس بالكفايات يتطلب مستوى عاليا من المهارة و معرفة واسعة بالعلوم التي تتماس مع التربية. و من خلال مقروئي في الساحة التربوية، فإن هناك قلة قليلة من الأبحاث التي تناولت موضوع الكفاية في الحقل التربوي العربي عموما و المغربي على الخصوص, و يهمنا في هذا المقام أن نعرف بالكتابات المغربية في هذا الموضوع :
- الكفايات في التعليم للدكتور محمد الدريج, فقد صدرت هذه الدراسة في شهر أكتوبر سنة 2000 ضمن سلسلة المعرفة للجميع . حيث يطرح الدريج مسألة الكفاية في علاقتها بسلم الأهداف و المحتويات و المنهاج الدراسي.
- الكفايات و استراتيجيات اكتسابها للأستاذ عبد الكريم غريب. صدر الكتاب في شهر فبراير 2001 يطرح فيه صاحبه مجموعة قضايا يمكن تلخيصها في خمسة عناصر:
1- الخلفية النظرية للتصور المتحمس للكفايات .
2- مرجعيات هذا التصور التربوية و البيداغوجية.
3- البنية المفاهيمية التي يتأسس عليها مصطلح " كفاية".
4- طرق و أساليب تكوين الكفايات.
5- أشكال و أساليب تقويم الكفايات.
- نحو بديل لتطوير الكفايات سنة 2001 للأستاذ مادي لحسن ينظر إلى الكفاية من خلال منظور وظيفي يتعلق بخريجي مدرسة تكوين المعلمين و المعلمات. كما نذكر بأن أول مقال في الموضوع كان قد صدر سنة 1999 في مجلة علوم التربية عدد 6/7 لعبد الكريم غريب تحت عنوان ( المنهاج و الكفايات ) إضافة إلى ما أصدرته مديرية التعليم الثانوي من نشرات في الموضوع. و يتعلق الأمر بمادة الفيزياء سنة 1996 و اللغة العربية سنة 1996. كما أن هناك بحثا في الموضوع أنجزه أحد خريجي مركز تكوين المفتشين سنة 1993 و لعل قيمة الحديث عن الكفاية, تنبع من مجموعة أسئلة حول مفهوم المعرفة و طريقة اكتسابها و علاقتها بالمعارف الإنسانية الجديدة و المعقدة, إذ أن العمل بمفهوم الكفاية يطرح إمكانية التركيز على ما يسمى بالمعرفة المتكاملة أو المعرفة المتصلة (التعليم المندمج ).
- تخطيط الدرس لتنمية الكفايات. سنة 2003 . وهوكتاب مترجم عن دراسة لمجموعة من المؤلفين .
وهناك مجموعة من الدراسات تناولت إشكالية الكفايات بطرق مختلفة و في مواد دراسية متنوعة مثل الاجتماعيات والأنجليزية والرياضيات والتربية السلامية.
و تجدر الإشارة إلى أن التحمس لمفهوم الكفايات لا يعني رفض العمل ببيداغوجية الأهداف, و إنما هي محاولة لجمع ذلك الشتات الصنافي انطلاقا من سؤال كيف نعرف؟ و ليس ماذا نعرف؟
2- أسئلة لا بد منها:
إن مجرد التفكير في عناصر هذا الموضوع, خلق لدي شعورا بالحاجة إلى التساؤل حول مجموعة قضايا تربوية و منهجية و تقنية هي:
أ- ما نوع و طبيعة الأهداف التي يمكن أن تحكم هذه الدراسة ؟
ب- ما نوع و حجم الصعوبات التي بإمكانها أن تعرقل أو على الأقل أن تواجه بها هذه الدراسة؟
ت- ما هي الوسائل الكفيلة بتطبيق هذا العمل؟
د- هل لهذه الدراسة أثر تربوي منشود؟
هـ: ما هي أدوات التتبع و التقويم؟
هذه الأسئلة و غيرها هي وليدة مخاض فكري و تربوي عميق ينطلق من قناعة هامة هي أن المعرفة العلمية عموما التربوية على الخصوص قد أصبحت قوة القوة في عصر تتهاوى فيه النظم و الأفكار الهشة, عصر تتقادم فيه الأفكار و الأشياء بسرعة مهولة و تشتد فيه حرب المعرفة التجريبية المتجددة باستمرار, و لا شك أن لهذا التطور المعرفي قوة تربوية و اقتصادية تمثل نوعا من السلطة الجديدة في عالم تسعى فيه الدول المتفوقة معرفيا و اقتصاديا و تربويا إلى تمرير قراراتها و تبرير ممارساتها و شرعنة أفعالها.
و انطلاقا من صميم وجودي الثقافي و المهني في عصر صناعة الثقافة و الإبداع, ارتأيت أن أطرح قضية الكفايات ( كثقافة تربوية مرتبطة بقدرة الفرد على امتلاك أدوات التعامل مع الظواهر الجديدة و المعقدة ) في مجال تدريسية مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي: بحيث سأركز على نماذج مقتضبة تهم مستوى السنة الثانية أدبي من سلك الباكالوريا و قد كان الهاجس الذي يحرك في داخلي حماسة التمسك بهذا الموضوع هو الرغبة المزدوجة في مراجعة شاملة لعلاقتنا مع تدريس مادة اللغة العربية, ثم محاولة خلق استراتيجيات و أولويات لاقتحام العوالم الجديدة و عصرنة الممارسة التربوية, ثم إن ذلك التكامل المعرفي الذي أصبح القاسم المشترك بين مختلف العلوم و فروعها المتخصصة يفرض علينا كفاعلين في الحقل التربوي أن نؤمن بوحدة المعارف و تداخلها. و ذلك انطلاقا من إيماننا بأن خريطة المعرفة ليست جزرا منعزلة.
2 أ ) أهداف الدراسة: تتوخى من هذه الدراسة تحقيق مجموعة أهداف:
- خلق ثقافة تربوية تحاورية مع فروع العلوم الإنسانية.
- التخلص من النزعة السلبية في التعامل مع الأدبيات التربوية الجديدة.
- الانتقال من موقع التفرج و الانبهار إلى مبادرة البحث و متابعة مستجدات الساحة الثقافية و التربوية.
- تنمية روح التجريب لدى المدرس و ترشيد استغلال المعرفة المستهلكة.
- التركيب بين ما هو بيداغوجي و ما هو ثقافي + معرفي + فكري+ علمي.
- الرفع من إيقاع التعلم و جعل المعرفة التربوية متعة و عشقا و ممارسة.
- الإجابة عن بعض المشكلات العالقة في الممارسة الصفية.
- خل تصور تكاملي للشخصية المستهدفة معرفيا ووجدانيا و حسحركيا.
- تجنب مفهوم المطلقية في التصور السلوكي و الاعتماد على الافتراض و التجريب و التطبيق و التتبع الموضوعي للمهارات و القدرا و الدوافع و الحركات.
و على ما يبدو فإن تحقق هذه الأهداف جملة و تفصيلا قد يعتبر وهما و طموحا, فوق المألوف, و لكننا نميل إلى تحقيق الحد الأدنى من هذا الطموح, أو على الأقل خلخلة التصورات الستاتيكية و زرع روح المبادرة و الإبداعية لدى المدرسين عامه, و خلق تواصل تربوي جاد و جديد بين المنتسبين إلى الحقل التربوي.
2 ب ) صعوبات و عوائق:
لا يمكن أن أنكر حجم الصعوبة التي تعترض متابعة العمل. لقد كنت متحمسا منذ بداية التسعينات لتطبيق ما أحمله من معطي نظري حول الكفايات بل أكثر من ذلك كان مقروئي للتجارب الأجنبية في هذا المجال يدفعني للمغامرة و التجريب. و لذلك حاولت أن أنقل تلك الحمولة النظرية إلى فضاء الفصل مع مجموعات تلاميذية مختلفة و لمستويات متباينة. و الحق أن هذه الدراسة المتواضعة هي ثمرة هذا المخاض العسير. و شعورا مني بأهمية و نتائج هذه المغامرة لا يمكنني إخفاء الصعوبات التالية:
2 ب1) صعوبات مادية و بشرية:
- غياب بنية تحتية مدرسية على مستوى الوسائل السمعية البصرية و التجهيزات المأمولة بصفة عامة.
- كثرة عدد أفراد مجموعة الفصل الدراسي. بحيث لا يمكن خلق مناخ تعلمي يحمل مواصفات المردودية و قابل للتتبع و التقويم الموضوعي.
- عدم تجانس أفراد جماعة القسم أو على الأقل تقارب المستوى اللغوي و المعرفي.
2 ب 2) صعوبات إدارية :
- إلزام المدرس باحترام الغلاف الزمني و تطبيق التوصيات التي تفتقر إلى المرونة.
- كثرة المذكرات و الخطابات الوزارية التي تعج بالخلط و التناقض و الاعتباطية. و تظهر هذه الحالة في وضعيات كثيرة: المراقبة المستمرة + الامتحانات + ...
- عدم تعاون إدارة المؤسسات التعليمية مع المدرس.
- عدم تناغم ساعات العمل مع الوضعيات النفسية و الجسمية للمتعلمين إذ غالبا ما تكون ساعة اللغة العربية بعد حصة الرياضة أو في آخر الفترة الزوالية.
3) الأثر التربوي المنشود من هذه الدراسة:
لكل عمل توقعات و أهداف مأمولة, و يبقى أثره المنشود مستقبلا هو الهاجس الذي يحرك الباحث و يحفزه للتمسك بمجموعة مبادئ و قناعات معينة و من بين النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا العمل:
- فتح آفاق المقاربة التربوية الاختلافية التي تقلص شقة التباعد الموجود بين مكونات اللغة العربية و آليات الفعل التربوي الخلاق.
- التأسيس لإيجاد طاقات بشرية مسكونة بمبدأ المبادرة والاختلاف و المثاقفة مع المحيط الخارج مدرسي.
- تصحيح صورة المتعلم السلبية عن مادة اللغة العربية التي وسمت بنعوت التحجر و القدامة و عدم القدرة على مواكبة ضرورات العصر.
-الاستجابة لحاجات المتعلمين العقلية المهارية المتجددة.
و يبقى هذا العمل كغيره من المبادرات مناسبة لفتح آفاق الحوار الثقافي و التربوي بين المهتمين و الفاعلين في الحقل التربوي. لأن تطور الممارسة التربوية رهين بالاجتهاد النظري و الميداني , كما هو مرهون بتبادل الآراء و الاستفادة من الخبرات. و لا شك في أن قيمة أي مشروع أو عمل تستمد ديناميتها و استمراريتها من خلال عمليات التقويم و التطوير و التجديد.
4) رؤية نقدية للتصور السائد حول مفهوم الكفاية:
في الكتيب الذي أصدرته مديرية التعليم الثانوي, قسم البرامج و المناهج و الوسائل التعليمية سنة 1996 نجد إشارة إلى مفهوم الكفاية و أنواعها و مجالاتها. و ذلك ابتداء من ص 10 إلى 16 و كذلك في صفحات 19- 41- 71-84. و يمكن إدراج هذا الكتيب الذي جاء مواكبا لأسس و منطلقات و مقاصد المناهج الجديدة آنئذ في ما يسمى بالدليل الذي يستأنس به المربي. بحيث نجد فيه حديثا عن بعض المرتكزات التربوية و العلمية و المؤسسية( ص 3) التي قام عليها المنهاج. كما نجد تفسيرا لمفهوم الكفاية ( ص 10-11) واستعراضا لمبررات اختيارها. غير أننا نتحسس في هذا الإصدار نوعا من الضبابية و الخلط في المفاهيم. و لتقريب الصورة أكثر، نورد هذا التعريف للكفاية الذي ورد في ص 10-11 " الكفاية بصفة عامة نظام داخلي للفرد غير مرتبط بمادة أو بوضعية معينة. و هي تتكون بفعل القدرات و المهارات و المواقف التي يكتسبها هذا الفرد. و في مفهومها التربوي استعداد يكتسبه المتعلم أو ينمى لديه لجعله قادرا على أداء نشاط تعلمي أو مهام معينة. و في توظيف آخر , هي قدرة المتعلم على حل مشكلات ترتبط بمهارات الفهم و التحليل و التطبيق". فالملاحظ في هذا التعريف أن الكفاية قد فسرت بمجموعة مواصفات هي:
- نظام داخلي للفرد تتأسس بفعل مجموعة عناصر لها علاقة بالتفسير الصنافي الثلاثي.
- هي استعداد بالاكتساب أو بتدخل أطراف خارجية.
- هي القدرة على حل المشكلات .
هذا التحديد الفضفاض للكفاية يدفعنا إلى التساؤل:
ما هي ماهية هذا النظام الداخلي للفرد؟ ثم هل الكفاية هي الهدف؟ و كيف يمكن أن تكون الكفاية استعدادا بالاكتساب و بتدخل أطراف خارجية و ما نوع ذلك الاستعداد ؟ معرفي؟ أم نفسي؟ أم لغوي؟ هل هي نشاط إرادي مرتبط بمنبهات ذاتية أم بعوامل خارجية؟
إن المتأمل في هذه المواصفات يتكون لديه وهم بوجود نظرة تجزيئية لمنظومة المعارف المفاهيمية المهارية المطلوبة. فالكفاية في الحقيقة ليست كالهدف الجزئي أو الإجرائي الذي يتحقق في وضعية تعلمية معينة. و هي مفهوم شامل له علاقة بالأغراض العامة للمنهاج. و قد يتحول ذلك الطابع الشمولي الذي يميز الكفاية إلى حد الغموض أو العمومية. و لذلك فالكفاية تحتاج إلى وقت زمني طويل نسبيا لكي تتحقق عبر مؤشرات متدرجة. لكن تلك المؤشرات قد لا تكون إيجابية في كل الأحيان. فقد تكون سلبية و دالة على عدم تحقق الكفاية . و هذه الازدواجية هي التي تخلق فينا وجع السؤال حول:
- قابلية تحقق الإنجاز من حيث الوقت و الوسائل.
- مجال المعارف و المهارات و القدرات و المواقف.
- معايير تصحيح الإنجازات و السلوكات و آفاق تطويرها.
- علاقة الإنجازات الجديدة بالمكتسبات السابقة و مشكلة تحويلها إلى مواقف جديدة.
- الحدود الزمنية التي سيبقى ذلك الإنجاز راسخا من خلالها.
فالكفاية قد تكون متعلقة بوحدة دراسية معينة خلال مدة زمنية غير يسيرة و قد تكون متعلقة بمستوى دراسي معين خلال السنة. و في هذه الحالة نطرح الإشكال التالي: هل يمكن الحديث بسهولة عن تحقق الكفاية التواصلية في مكون دراسي داخل مادة اللغة العربية و لمدة زمنية لا تتعدى حصة واحدة؟ أم أن لكل مادة دراسية كفايتها الخاصة بها؟ أم أن هناك قواسم مشتركة بين مختلف المواد رغم وجود فوارق معينة على مستوى البعد الثقافي لكل مادة.
و إذا أردنا معرفة موقع الكفايات في سلم المنظومة التربوية يحسن بنا أن نضع هذه الخطاطة التوضيحية:
الغايات كأهداف تربوية للمجتمع | المرامي التي لها علاقة بالنظام المدرسي | ||||||||||||||
الأهداف العامة المرتبطة بأسلاك التعليم | |||||||||||||||
الأهداف المرحلية المتعلقة بتنظيم مراحل انتقال المعرفة | الأهداف النوعية المرتبطة بنوعية المواد | ||||||||||||||
الأهداف الخاصة بمكون دراسي معين داخل مادة معينة | |||||||||||||||
الأهداف الإجرائية المرتبطة بحصة أو درس مخصوص | |||||||||||||||
فالكفايات تتموقع بين الأغراض و الأهداف العامة, و قد سميت الكفايات بالأهداف المكبرة.
5) الأهداف المكبرة Macro- objectifs أو الكفايات Compétences
اعتبرت كثير من الدول مبدأ الكفايات اتجاها جديدا في تصور الأهداف التربوية. فقد رأت هذه الدول التي تبنت نموذج التدريس بواسطة الأهداف أن هذا النوع من التعليم لم يعد بإمكانه أن يحقق نموا كاملا للشخصية , بسبب صعوبة تحديده تحديدا إجرائيا دقيقا. و هو الأمر الذي ساهم في تجزيء السلوك الإنساني و تحويل المتعلم إلى أداة تنفيذية, و غياب تخطيط هادف يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الفردية و اختلاف البيئات المدرسية. إن الكفايات تعتبر أهدافا نهائية تتكون من ترابط و تكامل عدد من الأهداف الفرعية. هذه الأخيرة يعبر كل واحد منها عن قدرة ذهنية أو مهارية أو وجدانية, و تتجلى هذه القدرات من خلال جملة من الإنجازات التي يقوم بها المتعلم.
5 أ ) التعاريف المعجمية و اللغوية و الاصطلاحية و البيداغوجية لمصطلح " كفاية":
*1 – لسان العرب لابن منظور: في المجلد الخامس عشر هناك إشارة في مادة كفى إلى : كفى – يكفي – كفاية - = إذا قام بالأمر, و كفاه الأمر = إذا قام فيه مقامه.
*2- المعجم الوجيز: ألف من طرف مجمع اللغة العربية في القاهرة. و يتبنى التعريف نفسه الذي قال به ابن مندور.
*3 – المعجم الوسيط في طبعته الثانية سنة 1972 يشرح: كفى الشيء = قام فيه مقامه ص 793.
*4- قاموس محيط المحيط لبطرس البستاني لم يذكر قط كلمة كفاية: و قد طبع سنة 1979.
*5- المعجم العربي الأساسي: صدر سنة 1991 من طرف المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم. جاء فيه ما يلي: كفاية مصدر كفى. فلان ذو كفاية = فهو ذو مقدرة ص 1048.
*6 معجم علوم التربية: جعل الكفاية هي القدرة. ثم جعل لها مقابلا هو La capacité و قد جاء فيه التعريف التالي:" قدرة الفرد أثناء مواجهة مشكلات ووضعيات جديدة على استدعاء معلومات أو تقنيات مستعملة في تجرب سابقة".
*7- المنهل للدكتور سهيل إدريس و هو قاموس فرنسي عربي صدر سنة 1996 و قد ورد فيه ما يلي: الكفاية = الجدارة و الأهلية La compétence
- · مفهوم الكفاية في المعاجم الأجنبية:
1*- قاموس Le nouveau petit robert الصادر سنة 1994 بشهر مارس فقد عرف الكفاية بما يلي: La compétence est une virtualité dont l’actualisation ( par la parole ou l’écriture) constitue la performance page421
و يمكن وضع ترجمة تقريبية لهذا التعريف بقولنا : الكفاية هي عبارة عن وجود ذهني مجرد، و الذي عن طريق تحيينه ( بواسطة الكلام أو الكتابة ) يؤسس الإنجاز. و يضيف هذا القاموس توضيحا آخر هو: Un homme compétent
- capable de bien faire
- capable de juger
2* القرص المدمج Encyclopédie en carta = جاء فيه أن كلمة
كفاية تعني = Aptitude= استعداد = ميل / Habilité= مهارة
3* قاموس: Dictionnaire de linguistique صدر سنة 1991 يقسم في ص 103 الكفاية إلى قسمين:
- كفاية عامة Compétence Universelle و يقول عنها:
Compétence formée des règles innées de toutes les langues
- كفاية خاصة : Compétence particulière
Formée des règles spécifiques d’une langue apprise grâce à l’environnement linguistique .
فالملاحظ في كل هذه التعاريف العربية و الأجنبية أن كلمة كفاية تعني: القدرة + المهارة + الاستعداد + القواعد الفطرية الداخلية لدى الفرد + الأهلية + الجدارة. و يمكن جمع هذه المرادفات في تعريف شامل بقولنا:
إن الكفاية شيء داخلي مجرد أو مبهم يتحول مع الممارسة و مواجهة المشكلات إلى إنجاز معين يثبت نسبة من القدرة على الفعل الكتابي أو الحركي .
- و عموما: يمكن لنا أن نخلص إلى ثلاثة تعاريف على المستوى اللغوي و الاصطلاحي و البيداغوجي:
-
- التعريف اللغوي: هي نسق من القوانين و الاستعدادات المتأصلة في الفرد و التي بإمكانها أن تؤهله للقيام بمجموعة من الإنجازات.
- التعريف الاصطلاحي : هي رؤية تربوية جديدة ذات فهم جديد لطريقة اكتساب المعرفة.
- التعريف البيداغوجي: إنها تعني مفهوم القدرة و المهارة بمعناهما المركب (3).
و قد وردت مجموعة تعريف للكفاية منها:
- هي استعداد ذهني غير مرئي و ذو طبيعة ذاتية خاصة (4).
- هي مجموعة من القواعد الداخلية التي توجه السلوك الخارجي للمتعلم(5).
- هي تعبير عن القدرة على إنجاز مهمة معينة (6).
- هي نظام من المعارف المفاهيمية و المهارية، تنتظم في خطاطات إجرائية، و تمكن في إطار وضعيات معينة من التعرف على المهمة- الإشكالية أو حلها بنشاط و فعالية (7).
- هي أهداف عليا أو كلية (8).
و كما تشير مختلف الكتابات التي تناولت مفهوم الكفايات, فإن هناك
أنواعا متباينة من الكفايات: كفاية معرفية + ثقافية + منهجية + تواصلية نصية + وجدانية + استراتيجية. و هذه الأنواع ترتبط بمجال معرفي أو مهاري معين.. بمعنى أنها تختص بمهمة محدودة و في إطار مادة دراسية معينة و بذلك يمكن تسميتها بالكفايات النوعية أو الخاصة أو الدنيا. في حين هناك كفايات يتضمن قدرا كبيرا من العمومية و التجريد. بحيث تتطلب قدرات مركبة. و تسمى بالكفايات العامة أو القصوى أو الممتدة .
5 ب- الفرق بين الكفاية و الهدف:
هل يعني الاحتفاء وبالكفاية, رفض مفهوم الهدف؟ الواقع أن العمل بالكفايات لا يلغي مفهوم الأهداف. و إنما يفتح إمكانية تطويرها بشكل تكاملي حتى لا يقع تجزيء العملية التعليمية. فالكفاية ترفض ذلك التقسيم الصنافي الذي يجزيء الإنسان. بمعنى أن الكفاية ترتكز على طابع الشمولية حيث تتوحد القدرات والمهارات المعرفية و الوجدانية و الحسحركية بشكل تكاملي. فالفرق بين الكفاية و الهدف يظهر في كون الهدف يدفعنا إلى التفكير في راهنية الحدث التعليمي, و بالتالي تغيب تلك النظرة الشمولية و الغائبة الاستقبالية. بينما تمثل الكفاية ذلك الهدف النهائي الشمولي ذي المقاصد البيداغوجية البعيدة المدى, و يمكن أن نوضح الطابع المميز للكفاية بسباق المسافات الطويلة فالمتسابق وهو في غمرة المنافسة يضع نصب عينيه نقطة الوصول النهائي. بحيث لا يمكنه أن يهدر جهوده منذ لحظات الانطلاق فهو يقوم بسباق يتأسس على جملة من الإنجازات و العمليات المتداخلة ذهنيا و حركيا و معرفيا. بمعنى أنه يحقق الكفاية النهائية عند خط الوصول عن طريق قدرات مركبة و عمليات متدرجة و إنجازات مترابطة و يمكن توضيح هذه الممارسة في الرسم التالي:
نقطة مواقف مناورة تكتيك حركات سرعة نقطة
الانطلاق معينة ذكية اختباري تمويهية نهائية الوصول
للآخر
المراحل و مختلف العمليات و الإنجازات
التي تؤشر على تحقق عنصر الأهلية و الجدارة ( الكفاية)
5ج- خصوصيات الكفاية:
يمكن هنا أن نحدد مواصفات الكفاية في:
- الشمولية
- التجريد
- الغائية
- ترابط المقدرات و المهارات و الوظائف بشكل جمعي ( سلوك مركب)
- الانتظام في وحدات و عناصر منسجمة.
- ذات طابع نسقي على عكس الصناعات.
- لها علاقة بالغايات و المرامي و الأهداف العامة.
- غير قابلة للملاحظة و التقويم المباشر
- تحتاج إلى مؤشرات, و التي تعتبر من تمظهرات تحقق الكفاية.
- ضرورة توفر قدرات (9) معينة تظهر في شكل مؤشرات.
6) مقاربة تجريبية للكفايات على مادة اللغة العربية ( درس النصوص المؤلفات )
6 أ – درس النصوص
تنهض هذه المقاربة التجريبية على بعض ثوابت تلك المعطيات المقترحة و لا أدعي في هذه الحالة التجسيد الكلي لسائر حيثيات الكفاية بكل مبادئها و مرتكزاتها و الوسائل العلمية لبلوغها و قد ارتأيت اختيار نموذج من مكون أساسي داخل اللغة العربية هو درس النصوص. وهكذا سيقع الاشتغال على نص شعري رومانسي مقرر للسنة الثانية من سلك الباكالوريا الشعبة الأدبية. و هذا النص للشاعر عمر أبو ريشة.
و قد كان الهدف من هذا الاختيار:
- تنويع الممارسة التربوية و إغناؤها.
- عدم الفصل بين مستويات الأهداف .
- تكوين تصور تربوي عن حدود و آفاق الاشتغال بمفهوم الكفايات .
- هجر تلك التمثلات البسيطة المسبقة عن درس النصوص.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة لا يمكن اعتبارها نموذجية بأي حال من الأحوال.
نــــــــــــســـر(10)
1- أصبح السفح ملعبا للنســـــــور فأغضبني يا ذرى الجبال و ثوري2- إن للجرح صــــيحة, فابـعثيـها فـي سماع الدنى, فحـيح سـعـــــير 3- و اطرحي الكبرياء شلوا مدمى تحـت أقـدام دهـــرك الســكـــــــير 4- لملمي يا ذرى الجبال بقايا النسر و ارمــي بــها صـــدور العــصور 5- إنه لم يــعد يكــحل جفـــن النجم تيــــــــــــها بــريشـــــــــــه المنـثور 6- هجر الوكر ذاهلا, و على عينه شـــــيء, مــــــــــن الوداع الأخـيــر 7- تاركا خلفه مـــواكــــــب سحب تتهــاوى مــــن أفقـــــها المسـحــور8- كم أكبــت علـــيه و هـــي تندى فوقــه قبلة الـــضــحى المــخــمـور 9- هبط السفح.. طاويا من جـناحيه عـــلى كــل مــطــــــمــح مــقبـــــور 10- فتبارت عصائــب الطير مــا بين شرود مــــن الأذى و نــــــــفـــــــور 11 لا تطيري, جوابة السفح, فالنســر إذا مــــا خبــــرته لــــم تــطــــــري 12- نســل الوهن مخلبيـه, و أدمــــت منــــكــبيه عـــــواصـــــــف المقدور 13- و الوقــــــــار الـذي يشيع عليـــه فضــلة الإرث من سحـــيق الدهـــور 14- وقــــف النــســر جائعـــا يتلــوى فـــوق شلو علــى الرمـــــال نـــــثير 15- و عـجـاف البغـــــاث تدفعــــــــه بالمخلب الغــض و الجناح القصـــير 16- فسرت فيه رعشـــة من جنــــون الكبــــر و اهـــتز هـــــزة المـــــقرور 17- و مضى ساحبا على الأفق الأغبر أنـقــــــاض هيـــكــــــــل مــــــــنخور 18- و إذا مـا أتـى الغياهـب و اجتــــاز مـــــدى الظــــــن من ضـــمير الأثير 19- جلجلت منـه زعقـة نشت الآفــاق حـــــرى من وهجـــــــها المــستـطير 20- و هوى جثة على الـذروة الشمـاء في حــــــضــــــن وكره المــــــهجور 21- أيها النسر هل أعـود كمــــا عدت أم الســفح قـــد أمــات شعــــوري |
مبادئ و مراحل و مقتضيات الدراس
1- مرحلة إغناء الرصيد المعرفي : أنشطة خارج الفصل قصد تهيئ مناخ التعلم
2- مرحلة اكتساب القدرة على فهم النص : التصورات و التمثلات و الفرضيات الممكن طرحها .
3- مرحلة الأنشطة المتعلقة بالتحليل : عمليات ضبط آليات التعبير الشعري و مضامينه الداخلية مع توظيف أدوات البرهنة, و المقارنة و التصنيف
4- و التمييز و الحكم.
5- مرحلة جمع المعطيات والتركيب والإنتاج الذاتي.
و يمكن توضيح قضايا و عناصر كل مرحلة في:
المرحلة الأولى تحضير المتعلم مجموعة معطيات حول النص و اتجاهه الأدبي.
حد لغوي
عتبة النص
حد مجازي
الأمر
الخطاب
الإخبار
المرحلة الثانية بعض تجليات الرومانسية في النص:الدوال + الفكرة + الموضوع...
v صورة النسر وصورة الشاعر.
v الأفعال والصفات المرتبطة بهما.
v الظواهر الصوتية والإيقاعية والبلاغية
المرحلــة الثالثـــــة
v مظاهر الرومانسية شكلا ومحتوى.
v مقارنة النص بنصوص أخرى لجبران ونعيمة وأبي ماضي.
المــرحلـة الرابعـــة: إنتاج تقرير قصير حول عناصر التطوير والتجديد في النص.
هذه العناصر أعلاه ليست نهائية, فهي مجرد معطيات سقناها فقط لتيسير مهمة قارئ هذه الدراسة أثناء عملية تخطيط الكفايات المنشودة، خاصة و أننا نهدف إلى الخروج بتصور واضح عن طبيعة الكفايات, و المهام التي بإمكانها أن تعطينا إشارة على إمكانية تحقق الكفاية في مستوياتها الغائية و الشمولية على المدى البعيد.
و حتى لا تبقى هذه الإستراتيجية القرائية مشلولة, سنحاول وضع جدول توضيحي نرسم فيه معالم هذه الممارسة التي التزمت بتبني مبدأ توظيف الكفايات في مادة اللغة العربية.
نوع الكفاية | نوع المهام المرتبطة بها | مؤشرات الإنجاز على المستوى الغائي البعيد المدى |
الكفاية الثقافية | - القدرة على معرفة التوجه الأدبي و الفكري للنص المقترح - الكشف عن مضمون الأبيات و مقصدية الشاعر - القدرة على إنتاج جمل قصيرة معبرة عن مدى فهمه لقصدية النص | * التعرف على القيم الإنسانية و الجمالية للأدب * الإلمام بصيغ الخطابات التداولية في الشعر العربي قديمه و حديثه * القدرة على إنتاج نص قصير أو تقرير عن قراءة خاصة بأسلوب هادف و سليم |
الكفاية المنهجية | - التدريب على امتلاك أدوات و بعض تقنيات الكتابة الإنشائية . - أن يقدر المتعلم على تنظيم إجاباته وفق سياق الموضوع الشعري *-أن يتدرب على مهارة التقديم و التأخير و التصنيف حسب أهمية الفكرة و موقعها | * إنتاج موضوع مترابط العناصر و متسلسل الأفكار و محكم منهجيا * اكتساب مهارة مقاربة النص من نواح مختلفة. * اكتساب مهارة و الفهم و التحليل و التركيب. * اكتساب حس أدبي يمكنه من معرفة آليات الخطاب و فق معايير معينة. |
الكفاية التواصلية | - الوصول بالتلميذ إلى مستوى القدرة على التمييز بين موقع المصطلح الأدبي في الجملة ووظيفته داخل النص الشعري - أن يتبنى بعض عناصر بناء الجملة الشعرية من حيث دوالها و تراكيبها الصرفية و النحوية و البلاغية خاصة و أنه أمام نص رومانسي - أن يعين في النص بعض الأساليب الشعرية ذات البعد الجمالي و الدلالي مثل الصورة (ش) | * التمكن من فهم ووصف الظواهر اللغوية داخل النصوص و معرفة وظائفها الدلالية و النفسية * إنتاج عمل ذاتي يتضمن حمولا و محمولات و انساقا جملية ذات وظائف فنية و دلالية . * القدرة على التحاور و التواصل بعفوية و بأسلوب المحاججة و البرهنة و الإقناع |
الكفاية الوجدانية | - القدرة على تحديد طبيعة القيم الإنسانية في النص - الوصول بالمتعلم إلى الاندماج في مناخ النص و تمثل تجربة الشاعر | * امتلاك حس أدبي يمكنه من تذوق الآثار الأدبية و التفاعل معها. * تمهيره على اكتساب قدرة تحليلية انطلاقا من ردود أفعاله الفكرية و النفسية نحو النص الأدبي. * القدرة على تجريب حواسه و أحاسيسه في مشاهدة عناصر الإبداع و الحكم عليها. |
6 ب ) درس المؤلفات:
في ضوء هذا المفهوم للكفاية كتركيبة متداخلة من القدرات و المهارات و الدوافع, تولدت لدي الحاجة إلى تجريب هذه القناعة التربوية عمليا على درس المؤلفات و ذلك إيمانا مني بأنه لا معنى للجهود التي تبنى فقط على الإشباع النظري و حسن النية, إذا لم يتم تعزيزها بأسئلة جديدة على محك الممارسة العلمية التجريبية. و لا يعني هذا الانفتاح على حقول علوم التربية نوعا من التعالي على شقوق الواقع و فجواته, أو تصورا فلسفيا خالصا يبحث عن الحقيقة. و في هذا الإطار تندرج هذه المحاولة. وانطلاقا من هذا الفهم عملت على تخطيط بطاقة تقنية مصنفة لمختلف الكفايات المنشودة. و حتى يتحقق قدر من النسبية في الوصول إلى ما هو متوقع من هذه المقاربة عمدت إلى البحث عن شروط و حوافز التعلم و ذلك بتحويل فضاء القسم إلى شكل محيط دائري و تقسيم التلاميذ إلى مجموعات عمل. و قد حرصت على أن يكون التجانس أو التقارب معرفيا و نفسيا بين عناصر كل مجموعة أحد أسباب نجاح التجربة. و أن تختار كل مجموعة منسقا أو مقررا لها. أما موضوع التجربة فهو الاشتغال على الفصل الأول تحت عنوان " العائلة" داخل كتاب " أوراق" لعبد الله العروي (11). و هو كتاب مقرر لتلاميذ السنة الثانية الأدبية من سلك الباكلوريا.
أشكال العمل الديداكتيكي
***********************
- عملية تنظيم عمل المجموعات
- عدد أفرادها ستة أفراد
- إطارها الزمني : ساعتان : ساعة للعمل الداخلي + ساعة للمناقشة الجماعية المفتوحة.
الفضاء الهندسي للقسم:
- تحويل القاعة إلى ورشة تتوزع في أركانها المجموعات .
- الإشراف: التوجيه + المساعدة + التذكير.
عملية بناء المجموعات :
- · عملية الهيكلة
- ترك حرية توزيع الأدوار لكل مجموعة .
- · إمكانية التجانس
- · الحرص على جعل كل مجموعة ذات تقارب معرفي و نفسي لتسهيل المهام .
طريقة العمل :
- تقاسم المهام بشكل مرض و اختياري.
أدوات العمل :
- · الكتاب المقرر + لوازم الكتابة.
منظومة المعارف المفاهيمية و المهارية المتوقعة: |
- وضع المتعلم أمام مجالات أوسع للتعلم الذاتي.
- الاحتكاك المباشر مع أطراف فكرية متباينة.
- إعطاؤه فرصة تجريب أدواته العقلية و مخزونه المعرفي .
- تحسيسه بأهمية التنظيم الذاتي و الإبداعية الفردانية.
- ترسيخ تقاليد الحوار و المحاججة .
- إشباع حاجاته المعرفية و النفسية وروح المبادرة .
و تجب الإشارة إلى أن هذه التجربة ذات الوجود النسبي بإمكانها أن تطرح إمكانية تبادل الخبرات في إطار أخلاقيات الحوار الجاد الذي يلزمنا جميعا بقناعة الاستفادة و تقبل عمليات التصحيح و المتابعة.
ورقة عمل المجموعة الأولى: استخراج المادة الحكائية:
أ) العلاقات الأسرية :
- الطبيعة الفكرية
- سلطة الأخ ص 17-21-24
- · غياب الأم
ب) مواقف إدريس من :
- المحيط = ص 15
- المرأة
- الحاجة إليها ص 20
- القطيعة معها ص 19
- الأدب الكلاسيكي + الرومانسي + الواقعي 23
- بعض المفاهيم الأخلاقية ص 22
ورقة عمل المجموعة الثانية : تحديد مواصفات شخصية إدريس:
الهيأة المزاج العقل الوجدان
ص 12 15 15 15
سلوكاته + أقواله + مواقف
ص 24-25 16 23
ورقة عمل المجموعة الثالثة: مرجعية سيرة إدريس:
- الطابع العقلي ص 14-15
- الطابع الثقافي ص 21
- الطابع الفلسفيص 15
ورقة عمل المجموعة الرابعة: دلالات سيرة إدريس:
دلالة معرفية
- أدبية
- تاريخية
- الاختيار الفلسفي في الحياة
- صورة المثقف و علاقته بالأسرة و المحيط الاجتماعي
بعد اشتغال المجموعات لمدة ساعة من الزمن, و بعد عمليات التوجيه و الترشيد و التذكير, أعيد تشكيل الفضاء الهندسي للفصل في شكل شبه دائري حتى يفسح المجال لبعض العناصر أن تستعمل السبورة أو توضح مقصديتها بطريقتها الخاصة. و هكذا يستمر النقاش لمدة ساعة من الزمن تقدم فيها كل مجموعة تقريرها. حيث تطرح الأسئلة ووجهات النظر بالشرح و النقد و التعليق و البرهنة. إذ يعتبر كل تلميذ ( سواء وسط مجموعته أو في وسط الجماعة ككل ) نفسه معنيا بالمداخلة و الدفاع عن آرائه.
خـــــــــلاصــــــــــــة
استرشادا بالمعطيات السابقة, نخلص إلى أن الحديث عن الكفايات - رغم ذلك التقسيم الظاهري - يمثل تصورا شاملا لطبيعة الإنجاز الذي يقوم به المتعلم. بمعنى أننا لا نستهدف سلوكا مجزأ عن باقي مكونات الفعل الإنساني. حيث تتدخل القدرات و المهارات و المواقف الوجدانية و الحسحركية في شكل وحدة أو بنية نسقية. ثم إن مبدأ العمل بالكفايات ينطلق من مسلمة أساسية هي أن المتعلم أمام مشكلات و مهام مركبة. و عليه أن ينجز مجموعة أنشطة متداخلة تمثل مقدمة لبداية تحقق الكفاية. أي أنه حين يكون قادرا على حل أو مواجهة مشكلة ما أو على الأقل معرفة كيفية تجاوزها فإنه يكون بذلك قد وضع مؤشرا على تمظهرات تحقق الكفاية المنشودة. و حين نتمسك بالكفاية كاتجاه جديد في التدريس, فإننا نؤمن بقناعتين: قناعة الانطلاق من مكتسبات سابقة, و قناعة الطموح إلى مستوى أرقى من مستويات القدرة و المهارة و الدافع و الحركة.
و انطلاقا من الممارسة الميدانية داخل فضاء القسم, تكونت لدينا قناعة بعدم تجزيء العملية التربوية. فهي كل متداخل و تعدد يتجانس في جزئياته بشكل بنيوي. و كلما اجتهد المدرس في تجريب أشكال بيداغوجية جديدة إلا و انعكس ذلك إيجابا على مردودية ونسبة التحصيل لدى المتعلم. و من شأن هذه الخطوة أن تخلخل الموقع التقليدي للمدرس من مالك للمعرفة, إلى موجه لها, و تحويل التلميذ من كائن مستهلك خاضع لسلطة الكتاب المدرسي و المدرس إلى ذات منتجة مسكونة بروح المبادرة و التجريب و الاستقلالية في التفكير.
هــــــــــوامــــــــــش
1) طرح هذا المفهوم في ندوة تحت عنوان: المناهج الدراسية و المستجدات التربوية. و ذلك بتاريخ 22-01-1994 ببني ملال. وقد شارك في الندوة محمود الدريج و أحمد بن عمو و أحمد أوزي.
2) عالم المعرفة عدد 265 يناير 2001 .
3) الكفايات و استراتيجيات اكتسابها. عبد الكريم غريب. فبراير 2001 ص 65
4) Vocbulaire de léducation. G. Mialaret.1979
5) الكفايات في التعليم. محمد الدريج – سلسلة المعرفة للجميع أكتوبر 2000
6) دولاندشير.
7) جيلي P. Gillet 1986 l’utilisation des objectifs
8) احمد المهدي عبد الحميد مجلة عالم الفكر 1988 ص 39
9) ذكر لفظ القدرة كمرادف للكفاية أربعين مرة عند الدريج . و تكرر هذا اللفظ ( القدرة) أربعة و عشرين مرة عند عبد الكريم غريب في ص 68-69-70
10) الكتاب المدرسي للسنة الثالثة الأدبية الثانوية. مطبعة النجاح الجديدة ط I . 1996 ص 68.
11) أوراق: عبد الله العروي ط II 1996 من ص 13 إلى ص 25 .
المــــــــــراجــــــــع
1) الكفايات في التعليم: محمد الدريج. سلسلة المعرفة للجميع اكتوبر 2000
2) الكفايات و استراتيجيات اكتسابها: عبد الكريم غريب فبراير 2002
3) بيير جيلي : L’utilisation des objectifs 1986
4) عالم الفكر 1988
5) عالم المعرفة عدد 265 يناير 2001
6)
7) رالف تايلر Des fins aux objectifs de l’éducation bruxel 1980
8) إدريس بومنيش Une pédagogie sans déchets
9) بيــرزيا : Birzia Rendre opérationnel les objectifs pédagogiques puf. Paris 1979
المعاجم
لسان العرب + المعجم الوجيز + المعجم الأساسي + المعجم الوسيط + قاموس محيط المحيط + معجم علوم التربية + المنهل لسيهل إدريس
Le petit nouveau robert + dictionnaire de linguistique .
.

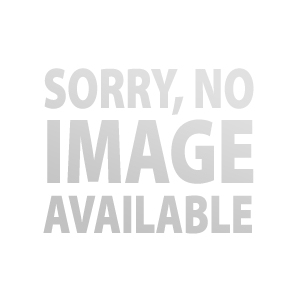
0 التعليقات:
إرسال تعليق