تدعيم آليات التأطير التربوي الأستاذ المرشد |
باسم الله الرحمان الرحيم
تدعيم آليات التاطير التربوي ( الأستاذ المرشد )
الأستاذ: المصطفى ملاك
مادة اللغة العربية
ثانوية ابن سينا التأهيلية
بني ملال
1) مدخل أولي
أصبحت العملية التربوية عبارة عن تجربة تاريخية تراهن على خلق مجتمع معرفي، وتربط بإشكالية التعلم بتمهير الفرد في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، واستنبات قيم إنسانية تستجيب لمطالب العصرنة وإكراهات الرهان الحضاري. ولم تعد المدرسة هي ذلك الفضاء المكاني الذي تذوب فيه الموارد البشرية يشكل اعتباطي، دون اعتبار للمنتوج والمردودية . فقد تحولت إلى مشروع مجتمعي يساير عالمية التثاقف، ويواكب التحولات الممكنة، أو المراد لها آن تكون.
وانطلاقا من هذا الفهم، يظهر جليا أن المعرفة التربوية يجب أن تقوم على مبد أ الإنتاجية وحمى الاجتهاد، وفضول المغامرة، والكشف. وغير خاف أن نقل وتحسين المعرفة له علاقة ليس فقط بالمحيط المدرسي، ولكن أيضا بالمنظومة الإعلامية والسياسة التنموية، والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بتوجهات الدولة، وخصوصية المجتمع، وكذا رهانات العصرنة. فإذا سلمنا بهذه الحقيقة، سيصبح الحديث عن التمدرس، وما يرتبط به من نظم ثقافية، وأنساق اجتماعية ، رهينا بطبيعة الفاعلين في الشأن التربوي، إضافة إلى شركاء آخرين من داخل أو خارج المنظومة التربوية.
ومن البديهي أن هناك طرفين أساسيين معنيان بجدوى الممارسة التربوية، باعتبارهما مكلفين بجملة من المهام، يمكن تلخيصها في : الإرشاد/ المراقبة/ نقل المعرفة / التوجيه/ التنسيق/ التأطير/ التكوين.
إنهما المدرس (ة) والمشرف (ة) التربوي (ة). وذلك بحكم علاقتهما المباشرة مع الأقسام ، والأطر الإدارية ، وجمعية الآباء. واسترشادا بهذه المعطيات ، يبدو السؤال حاضرا وبإلحاح حول :
أ/ طبيعة الإشراف التربوي الذي يتهم عادة بكونه بقي بعيدا عن البحث التربوي ميدانيا ونظريا، وظل أسير التقارير المدبجة بشكل رتيب، راكنا إلى التخفي وراء أقنعة المذكرات الوزارية التي تعج بالمتناقضات، أومسكونا بهواجس تلك المطويات والكتيبات التي يتراكم بعضها فوق بعض دون أية حركية ملحوظة.
ب/ دور المدرس كطرف مسؤول عن تمرير المعرفة وتنظيمها وتحويلها إلى معطى ديداكتيكي يلائم حاجات المتعلم ومطالب التحديث. فالمدرس في نظر الكثيرين قد بدأت تصدأ أسلحته المعرفية، وتتآكل معرفته البيداغوجية، أمام تراجع الاجتهاد الشخصي وفراغ التأطير، وانعدام التنسيق، في غياب حلقات تكوينية تأخذ بأحدث المقاربات البيداغوجية.
ومن خلال هذه الرحلة القصيرة في مسارب هذا النسيج (المعرفي – التربوي) ، تظهر الحاجة إلى تبادل الخبرات في إطار تشاركي- تشاوري مبني على تقنيات تواصلية هادفة بين المدرسين على مستوى كل المواد والتخصصات من جهة وبين المدرسين والمشرفين التربويين من جهة أخرى.
لكن واقع الإشراف التربوي بما له وما عليه لا يمكن أن يطلع بكل حيثيات ومطالب الممارسة التربوية، لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. إذ يبقى المدرس هو المعني الأول بنقل المعرفة وتجديد آلياته، وخلق شراكة مع زملائه وتلامذته. ولكي يتحقق الارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات و الأساتذة، وتطوير علاقات التعاون، وتبادل الخبرة بينهم، تظهر الحاجة إلى الأستاذ المرشد والأستاذة المرشدة.
وفي إطار هذه الشراكة المعرفية والعلاقات التعاونية بين هيأة التدريس، يندرج هذا المشروع المتواضع، والذي تحركني فيه رغبة خوض غمار تجربة جديدة تنضاف إلى تجارب سابقة. إنها تجربة الأستاذ المرشد المسكون بهاجس الهم الثقافي والمهني، والمسافر في رحاب الشأن التربوي بمختلف تصوراته الفلسفية، ونظريات صناعة المعرفة التربوية.
2) أسئلة لابد منها
إن مجرد التفكير في هذا المشروع، قد خلق لدي شعورا بالحاجة إلى التساؤل حول مجموعة من القضايا :
* ما مدى قابلية هذا المشروع للتنفيذ؟
* ما نوع الأهداف التي يروم هذا المشروع ( التصوري) تحقيقها؟
* ماحجم الغلاف الزمني الذي سيتم فيه إنجاز هذا المشروع؟
* ما نوع وحجم الحاجيات الممكنة ، أو المتوفرة لإنجاز هذا المشروع؟
* وما طبيعة الصعوبات التي بإمكانها أن تعرقل هذا المشروع؟
هذه الأسئلة وغيرها وليدة مخاض فكري وتربوي ينطلق من قناعة هامة. هي أن المعرفة التربوية أصبحت قوة القوة في عصر تتهاوى فيه النظم والأفكار الهشة، وتزداد فيه الحاجة إلى التجريب والمعرفة المتجددة باستمرار. لقد أصبح الشأن التربوي كدينامية جديدة في مجالات التكوين والتأطير نوعا من السلطة الرمزية في عالم يسعى فيه كل طرف متفوق معرفيا وتربويا إلى تمرير قوانينه وقراراته، وتبرير ممارساته. وانطلاقا من هذه القناعة، ارتأيت أن اطرح هذا المشروع كواحد من التصورات حول الأستاذ المرشد.
3)تشخيص الوضعية
من البديهي أن أي دراسة ، أو مشروع، أو تصور، أو قوة اقتراحية، لا بد وان تنطلق من رؤية تشخيصية للواقع أو للظاهرة المعنية بالمشروع . وعلى ضوء هذا المبدأ ، يمكن أن نشخص ولو في عجالة بعض الجوانب المرتبطة بالحياة المدرسية، وبخاصة ما يتعلق بتدريسية مادة اللغة العربية .
تكتسب مادة اللغة العربية أهمتها من مجموعة مرجعيات ( دينية / دستورية / تاريخية / حضارية) إضافة إلى كونها مرتبطة بالهوية الوطنية ، والخصوصية الاجتماعية . ثم إن مجرد التفكير في المسار المنهجي والديداكتيكي لهذه المادة بمختلف مكوناتها ( نصوص + ظواهر بلاغية ، إيقاعية ، نحوية ، صرفية ، تركيبية + درس المؤلفات الذي له خصوصيات سردية ، حوارية ، فكرية ، ثقافية) يعتبر في واقع الأمر دعوة إلى إعادة النظر في تلك الممارسات العفوية ، من أجل بناء تصور بيداغوجي صحيح يناسب خصوصية المادة ، وينفتح على مستجدات النظريات التربوية. فالمفاهيم الحماسية المشحونة بالإغراء ، وكذلك تقليدية الإلقاء بالكم المعلوماتي على حساب التعلم الذاتي، والاحتفاء بالتوصيل أكثر من التواصل ، كلها أساليب لم تعد تجدي نفعا في عصر الثورة المعلوماتية ، وأمام متعلم تتجاذبه ثقافة الصورة والأنترنيت . كما أن الوقوف عند حدود المنفعة ( الامتحان ) أو المراهنة على الذاكرة وحدها ، أو تلقين القواعد بشكل مسطح وآلي بعيدا عن التوظيف الدلالي والتحويل الديداكتكي ، قد أضعف جاذبية التعلم عند التلميذ ، وقتل فيه روح المبادرة والرغبة في الملاحظة والتجريب . يجب أن يتحول درس اللغة العربية إلى مشروع تربوي يجمع بين ثوابت المادة وضرورة البحث البيداغوجي حتى تتضح طبيعة الأدوار والمهام ، وأشكال العمل الفردي والجماعي انطلاقا من فعل الإنصات والمشاهدة ، والقراءة ، والكتابة ، ومرورا بتجربة الابتكار ، إلى مايرافقها من فهم، ووصف، وتحليل ومناقشة، وتركيب ، وحل للوضعيات الصعبة والمشكلات المستجدة. ولا يمكن أن تتحقق هذه المواصفات دون وجود آليات للتأطير التربوي ، ورفع درجة القدرة التدبيرية للأستاذات والأساتذة . إضافة إلى علاقات التعاون، وتبادل الخبرات بعقلية منفتحة ، بعيدة عن التحنيط ، والتعصب، والتحجر الفكري مع قبول الآخر، والإيمان بمبدأ الاختلاف.
ولعل مهمة الأستاذ المرشد تبدأ من هذه الحلقة المفقودة . فهو الذي ينسق بين المدرسين ، ويخلق علاقات تواصلية دائمة داخل المؤسسة ، وعبر فضاءات أخرى . وتزداد الحاجة أكثر إلى هذا العنصر( المرشد) في عمليات تأطير الأستاذات والأساتذة المبتدئين،بصدر رحب وأريحية تربوية.
4)الأستاذ (ة) المرشد (ة)
لايمكن الادعاء بأن الأستاذ المرشد له مواصفات متفردة . فالمعرفة لاحدود لها ، وحدودها مدحوة بلا نهاية. فالخبرة في مجال التدريس ، والتمكن من منهاج المادة ، والقدرة على التواصل، وإتقان آليات التنشيط تعطيه صلاحية تحمل هذه المسؤولية. كما أن روح المبادرة ، وعشق البحث ، وكفاية التحاور الثقافي والتربوي في إطار العلاقات الإنسانية والمهنية، تؤهله مبدئيا لهذه المهمة. وبديهي أن كل تجربة محكومة باحتمال الضعف والقوة . ويبقى الضمير الحي ، وحسن النية كفيلين بنجاح هذه المهمة . كما أن سلوك المتابعة والتقويم ، والنقد الذاتي ، عوامل كفيلة بزرع روح المعاودة والتصحيح ومتابعة البحث والتجريب ، والاعتراف بالمبادرات الجادة .
فالأستاذ المرشد بحكم خبرته المتراكمة ، وكفايته التواصلية قادر على تقريب المسافة بين المدرسين في أفق شراكة موسومة بطابع المصارحة ، و الصدق، والمشورة . فما أحوجنا إلى العمل الجماعي حتى تترسخ لدينا ثقافة عمل المجموعات ، أو فرق العمل التي تتبادل المعلومات والجذاذات ووسائل العمل . فهذه السلوكات المنشودة لا يمكن أن تكون في نظرنا ذات قيمة إذا لم نعمل على ترجمتها إجرائيا إلى واقع عملي مهما كانت المشكلات والعوائق. لأن مهمة المدرس الباحث لا يمكن أن تقف عند حدود الانغلاق على الذات أو الاجترار . فهو أمام مسؤولية مزدوجة : تجديد معرفته باستمرار ، وتقديم هذه المعرفة بطريقة تتناسب مع الحاجة ، وتتكامل مع تجربة الآخرين .
إن الأستاذ المرشد قادر على ربط حبل التواصل ، وتهيئ الظروف المناسبة لتتكامل الجهود خدمة للصالح العام ، وارتقاء بالمستوى التعليمي عموما ، وبأساليب تدريس مادة اللغة العربية . ويمكن إجمال بعض المهام الموكولة إلى الأستاذ المرشد ، أو الأستاذة المرشدة في :
- المشاركة في إنجاز البحوث الميدانية
- تأهيل حديثي العهد بالتدريس على تطوير أدائهم وإنماء كفاياتهم
- المساعدة على حل بعض المشكلات بين أساتذة المادة
- تحقيق التواصل الاجتماعي والتربوي ، وتمتين الروابط الإنسانية
- تنويع قنوات التواصل داخل المؤسسة وخارجها ، وتوسيع آليات الإخبار
- المشاركة في توحيد الجهود نحو عمل تشاركي فعال .
- الحرص على الاتصال المباشر وغير المباشر، بمختلف اتجاهاته وأنواعه:
أ-اتجاهات الاتصال
من أعلى إلى أسفل تدفق المعلومات والأفكار والمقترحات، والتوجيهات من المفتش إلى المدرسين و المدرسات .
من أسفل إلى أعلى الانطلاق من ذلك المدرس المبتدئ إلى أكثرهم خبرة. وهذا النوع يساعد على معرفة وتقبل الأفكار المقترحة، كما يساعد على الإسهام بأفكار قيمة،و يزيد فرص الارتباط بمناخ العمل
الاتصال الأفقي يكون بين أساتذة يقومون بمهام مشتركة، أو تجمعهم أقسام متقاربة ومستويات مشتركة. بحيث يسهل انتشار المعلومات المفيدة، ويتم تبادل الأفكار والأدوار دون إحساس بعقدة النقص أو التفوق.
ب-أنواع الاتصال
- رسمي: ويكون عبر قنوات ووسائط داخلة في نظام رسمي، تخضع لمساطر معينة وضمن مذكرات تنظيمية .
- غير رسمي: ويقوم على أساس العلاقات الشخصية والاجتماعية بعيدا عن الإحساس بالفوارق . وهذا النوع سيساعد في معرفة أشياء غاية في الأهمية قد لا يتحقق وجودها في التواصل الرسمي. إضافة إلى أن هذا النوع الاتصالي يقوي روابط الصداقة، والعلاقات الإنسانية الحسنة، ويشجع على التضحية والعمل أحيانا خارج أوقات العمل المألوفة.
ومن المعلوم أن الأدبيات التربوية تعتمد على ما يسمى بالمنشط. إذ بدونه لا يحصل تقدم في العمل. ومعلوم أن المنشط هو المسؤول على المجموعة التي تتعامل معه . فالأستاذ المرشد بحكم مسؤولياته مطالب بعقد اجتماعات ولقاءات دورية، أو استثنائية مع زملائه في المؤسسة. وهو في الواقع يتحمل مسؤولية خاصة في التنظيم والتنسيق، ومساعدة الآخرين، والحرص على التطبيق الجيد للقرارات .
وتـأسيسا على هذا الفهم فإن هذه المهمة تتطلب مؤهلات القيادة، والتسيير، والتنشيط القادر على تنظيم العمل، ومواجهة مختلف الوضعيات العلائقية، وبعض المواقف السلبية، مع احترام مبدأ الرأي المخالف، وفضيلة الإنصات الحقيقي للآخرين، وفهم مقاصدهم
بهذه المواصفات ستصبح خلية اللغة العربية قادرة بإذن الله على تشخيص الصعوبات واستيعاب الحاجات، وبناء علاقات متميزة مؤسسة على التفهم، والإرشاد، والمساعدة، وتبادل الأدوار. كما ستتهيأ فرص الانفتاح على المواد الأخرى ، وعلى شركاء آخرين للارتقاء بالمستوى الإنتاجي، وتحقيق قدر كبير من الجودة، والفعالية. كما أن احترام الحقوق ، وقواعد العمل الشفاف سيوسع قاعدة التشاور، ويحول أساتذة هذه المادة إلى محاور هام داخل المؤسسة ،أو في فضاءات أخرى، وشريك فعال له نصيب هام من المصداقية، والاحترافية.
ومن شأن هذا السلوك العملي أنه يمكن أسرة تدريس مادة العربية أن تتحول إلى ورشة عمل حابلة بالحركية. لأن الإيمان بالتشاركية في أداء المهام يذلل الصعوبات ويفتح آفاق الكشف عن الممكن ، وما يجب أن يكون. كما ستصبح االمادة المدرسة منفتحة على عوالم خارجية ، تكون لها رافدا أضافيا، وشراكة استقبالية لا تعرف الكلل أو التردد. وفوق هذا المكسب، سيكون مدرسو مادة اللغة العربية متشبعين بثقافة الحوار والتعاون، متسلحين بفضول المساءلة ، ونكران الذات
5) برنامج العمل السنوي
يصعب وضع وصفة جاهزة وكاملة للبرنامج السنوي للإرشاد التربوي . لأن هذه العملية تطلب تواصلا قبليا واستشاريا مع السيد المكلف بالتفتيش ، والذي يبقى بدوره محكوما بمتغيرات غير متوقعة في علاقته بالنيابة ، أو بالمركز الأكاديمي . ثم إنه لا يمكن بأي حال أن نتحكم في الحدود الزمنية نظرا لاعتبارات فوق طاقتنا . ومع ذلك يمكن الاستئناس بهذا البرنامج المتواضع :
الزمن | الأنشطة خلال السنة الدراسية | الأهداف | إجراءات التقويم والمتابعة |
خلال
الدورة
الأولى
خلال
الدورة
الثانية
| - مدارسة المذكرات التنظيمية ، وبعض الإجراءات التشريعية ، والنشرات الإخبارية
- تنظيم عروض حول المستجدات التربوية. وخاصة ما له علاقة بالمادة - تنظيم لقاءات عند الضرورة لتدارس وضعية المادة والمشاكل المرتبطة بها
- القيام بندوات لها علاقة بالجانب التثقيفي ن وبحضور التلاميذ - تبادل زيارة الأقسام والجذاذات
- تنظيم أيام ثقافية أو معرض للكتاب لتنمية مهارة القراءة عند التلاميذ وإشراكهم في مهمات محدودة
- استدعاء بعض المبدعين في القصة والشعر والمسرح، وعلوم التربية
- استغلال الوسائط الحديثة في إنجاز دروس مشتركة
- القيام بزيارات ميدانية أحيانا لبعض المؤسسات ذات التجارب الريادية
| - التذكير بالمسؤولية الإدارية والتربوية والقانونية
- تجديد المعرفة ومواكبة المتغيرات -حل المشاكل العالقة والاستفادة من الآخرين
- تعزيز المكتسبات واختبار الذات - تطوير أساليب العمل
- التشجع على مرافقة الكتاب أمام ثقافة الصورة
- تبادل المعلومات وفتح آفاق أوسع
- وضع الذات في سياقات تربوية مغايرة
- القيام بمساءلة الذات حول حدود الخبرة | القيام بمراقبة الحصيلة
المعرفية، والانخراط
في تجربة المنافسة
والاحتكاك، والإحساس
بضرورة الإنتاجية
تقويم القدرات المعرفية
والمؤهلات المهنية
والمهارات التواصلية
في سياقات ووضعيات
مختلفة. |
من خلال المعطيات السابقة يظهر أن مهمة الإرشاد التربوي عبارة عن عملية تشاركية . بحيث تتكامل التجارب والخبرات ، ويسود جو من التفاهم والتواصل ، وتبادل المهمات بروح من المسؤولية ونكران الذات ، بعيدا عن الحسابات الضيقة والنزعة التواكلية . ثم إن الأداء التربوي الفعال لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال فردانيا منعزلا ، أو منغلقا على أحادية المعرفة . إن هناك علاقة قوية بين المنظومة الثقافية و التربوية من جهة, و بين المتغيرات المتسارعة التي تحدث من جهة أخرى على صعيد المحلية و العالمية. و من هذا المنطق, ارتبط المجال التربوي بالعلوم المجاورة له, و كذا بفلسفات و تصورات المجتمعات الإنسانية .
فالمدرس مطالب بتجديد أسلحته المعرفية ، ومساءلة الذات ، حتى يمارس مهامه في سياقات تربوية تتسم بالحيوية والحركية التي لا تعترف بالحدود الثقافية والتربوية . فالعلم يتغير ، والحدود الجغرافية أصبحت وهمية في زمن يشهد تدفقا في المعلومات ، وفيضا هائلا في النظريات التربوية . وبهذا الفهم أصبح المدرس مطالبا بأن يتعلم كيف يعلم الآخرين . فهو مدعو إلى المعرفة المتكاملة أو المعرفة المتصلة ، و ربط نظرية التعلم بوضعيات إشكالية ، وتحويل المعرفة إلى أنشطة قائمة على : استثمار المكتسبات السابقة بشراكة ، وتعاون جماعي لمواجهة المشكلات ، والبحث عن الحلول المبنية على المبادرة ، والمساءلة ، و النقد .
إن البيداغوجيا الحديثة تنظر إلى المدرس الباحث باعتباره عنصرا منتجا ، ومساهما في تطوير آليات البحث التربوي ، وقيمة مضافة في الادبيات التربوية . وهو بذلك سيحدث نقلة متميزة في التعامل مع مشكلات التعلم . فالمبادرة والتجريب أصبحا عنده التزاما ، و رسالة تعبر عن شكل مسار التعلم وتفصح عن وجود ضرورة للانفتاح على مقاربات نظرية و بيداغوجية فعالة . فلا بد من الرغبة المزدوجة في مراجعة شاملة لعلاقتنا مع تدريس مادة اللغة العربية, ثم محاولة خلق استراتيجيات و أولويات لاقتحام العوالم الجديدة و عصرنة الممارسة التربوية . إن ذلك التكامل المعرفي الذي أصبح القاسم المشترك بين مختلف العلوم و فروعها المتخصصة يفرض علينا كفاعلين في الحقل التربوي أن نؤمن بتعددية المعارف و تداخلها. و ذلك انطلاقا من إيماننا بأن خريطة المعرفة ليست جزرا منعزلة.
ولذلك نجد أن هناك حاجة إلى الرغبة المزدوجة في مراجعة شاملة لعلاقتنا مع تدريس مادة اللغة العربية, ثم محاولة خلق استراتيجيات و أولويات لاقتحام العوالم الجديدة و عصرنة الممارسة التربوية . إن ذلك التكامل المعرفي الذي أصبح القاسم المشترك بين مختلف العلوم و فروعها المتخصصة يفرض علينا كفاعلين في الحقل التربوي أن نؤمن بتعددية المعارف و تداخلها. و ذلك انطلاقا من إيماننا بأن خريطة المعرفة ليست جزرا منعزلة.

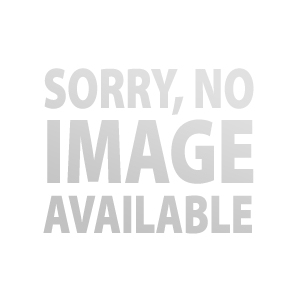
0 التعليقات:
إرسال تعليق