بسم الله الرحمان الرحيم
عنوان الدراسة قراءة نقدية في بعض جوانب الحياة المدرسية
عناصر الموضوع:
1تقديم
2 واقع التمدرس في المؤسسة المغربي
أ- صورة المدرسة
ب- صورة المتعلم
3/ واقع الأكاديميات الجهوية
4/ المعرفة المقدمة كسؤال إشكالي
5العلاقة الصدامية بين( المدرس – التلميذ – الإدارة – الآباء)
6 حرب التعلم
7/ علاقة الفضاء التربوي بحقوق الإنسان
خلاصة
1/ تقديم
لم تعد النظم التربوية الحديثة رهينة بالحسابات الاقتصادية والسياسية الضيقة. و اقصد بذلك إقحام المشروع التربوي في لعبة الأدلجة واستهلاكية الدعاية المبنية على خدعة الشعارات البراقة، والمفاهيم المشحونة بالإغراء والحماسة الزائدة، لأن العملية التربوية عبارة عن تجربة تاريخية تراهن على خلق مجتمع معرفي، و تربط إشكالية التعلم بتمهير الفرد في مختلف العلوم، واستنبات مبادئ العدالة ،والمساواة،و الكرامة الإنسانية في أبعد صورها الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية. ولن يتم ذلك إلا بالتصدي لمظاهرالعجز والإخفاق و أسباب الفشل، وامتلاك الجرأة على تحديد مواطن الخلل، والتقصير، دون تعليق عقدة الخوف على أسباب واهية.
ولم تعد المدرسة هي تلك البناية التي تعجن فيها الأرقام البشرية المحكومة برنين الجرس المعلن بشكل روتيني مقرف عن وقت الدخول والخروج دون اعتبار للمنتوج والمردودية. ولعل المؤسسة التعليمية المنغلقة على ذاتها، والمعزولة عن خارجيتها، ليست في الحقيقة سوى روض للكبار والصغار معا، يستهلك فيه الوقت ويضيع فيه الجهد والمال إلى أجل غير مسمى . فإذا كان لكل مجتمع بسيط أومركب مشروعه الثقافي، فإن للمدرسة أولويات ومسؤوليات، إذ أن الشأن المدرسي يمثل وجه المجتمع، ويعكس فلسفة الدولة، وآفاق التحولات الممكنة، أوالمراد لها أن تكون.
وعلى ضوء هذا المخاض العسير، بين ماهو كائن وما يجب أن يكون، يبدو سؤال المعرفة حاضرا وبإلحاح:
ماهو نوع المعرفة التي تقدمها المدرسة؟
هل البرامج والتوجيهات وعمليات الإصلاح ، وإعادة الهيكلة ، وغير ذلك من الشعارات ، والملتقيات ، والمنتديات قادرة على بناء مجتمع معرفي يساير عالمية التثاقف؟
ماحجم ونوع المهام المطروحة على نظامنا التربوي؟
وغير خاف أن نقل وتحسين المعرفة له علاقة ليس فقط بالمحيط المدرسي، ولكن أيضا بالمنظومة الإعلامية والسياسة التنموية. وانطلاقا من هذه الحقائق نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بان نظامنا التعليمي بحاجة إلى إعادة النظر بشكل موضوعي وبروح من المسؤولية في جملة من القضايا منها:
ü تحديد طبيعة الفاعلين تربويا وبيداغوجيا وثقافيا
ü إعادة النظر في نوع وطبيعة الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي
ü طرق التدريس وعلاقتها بمسألة التكوين وإعادة التكوين
ü نوع وحجم وطبيعة المعرفة المقدمة في مختلف المواد الدراسية
ü واقع المدرسة التي فقدت مصداقيتها أمام زحف التعليم الخصوصي وسماسرة الساعات الإضافية
ü نظام الامتحانات الذي تحول إلى ساحة للغش بكل الوسائل في غياب مسطرة قانونية واضحة وزجرية، دون اللعب على حبل الهاجس الأمني ، وتبيح الغش بشكل ملتو ترفضه الأخلاق والقوانين الإنسانية.
ü العقلية الإدارية التي صدئت، ولم تعد قادرة على تدبير المدرسة بأسلوب تربوي عصري
ü طبيعة العلاقات بين داخلية المدرسة وخارجيتها من جهة ، وبين المدرسة والجهازين :النيابي والأكاديمي.
2/ واقع التمدرس في المؤسسة المغربية
الحديث عن ا لتمدرس وما يرتبط به من قيم تربوية، ونظم ثقافية، وأنساق اجتماعية لايكون مشرعنا ما لم نتوقف عند الفضاء المدرسي الذي تتم فيه عملية التعلم. فهناك طرفان أساسيان في عملية التعلم.( المدرس والمتعلم) مع العلم أن هناك أطرافا أخرى لها صلات مباشرة بهذه العملية، في مقدمتها الطاقم الإداري، وجمعية آباء وأمهات التلاميذ والتلميذات ، دون أن نغفل دور الجمعيات ، ومكونات المجتمع المدني عموما . والملاحظ من خلال هذه الشراكة المعلنة ، أوالمضمرة، أن التعليم قضية وطنية بامتياز، وبالتالي يجب النظر إليه كأسلوب حضاري. ومن بين هذه العناصر مجتمعة يبقى المتعلم هو الرأسمال الأساس في كل مخطط تعليمي، لأنه في نهاية المطاف يمثل الوجه الحقيقي الذي نقيس به الاختيارات الثقافية، والاقتصادية، والسياسية للدولة.
أ- صورة المدرسة
هي إطار مؤسسي مقنن بجملة من الشروط القانونية والتربوية ، وهي في الواقع بناء هندسي تمرر داخله ترسانة من الأنساق الثقافية، والنظم المعرفية. ومن المفروض ،والحالة هذه أن تكون العلاقات داخل المؤسسة مبنية على الفاعلية والاحترام المتبادل ، مع الانفتاح على ماهو خارج السور المدرسي. وهذا طموح مثالي في ظاهره ، لكنه يختزن تناقضات كثيرة سواء على مستوى العلاقة بين أطراف المدرسة، أوعلى مستوى وظيفة كل طرف على حدة.ويبقى السؤال المقلق هو: إلى أي حد ساهمت المدرسة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وإنتاج ثقافة جادة وفعالة ؟ هل مدرستنا فضاء لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان؟ هل هي قادرة على إنتاج خطاب معرفي حداثي يساير التطور الحضاري؟ فالمدرسة مساحة للتعلم، ومختبر للتجريب، وإطار نموذجي لعلاقات إنسانية، واجتماعية، وثقافية جادة. وهي بذلك فضاء تتداخل فيه عناصر متعددة: المدرس+ المتعلم + المناهج الدراسية + هيئة التسيير الإداري+ الأسرة + المجتمع + جمعية آباء وأمهات التلاميذ. ولعل المثير في هذا التداخل هو وجود ثقافة أخرى رمزية تتسرب إلى داخل المدرسة، سواء ما تعلق منها بالقيم الخارج مدرسية، أو تلك الأنساق الاجتماعية، والسياسية التي تتدخل بشكل مباشر ، أو غير مباشر في الشأن المدرسي . وهنا يظهر الحديث عن أهمية التجانس بين كل تلك الأطراف المذكورة . والحال أن التناقض المهول الظاهر في طبيعة وظيفة كل طرف يفضح غياب التواصل ، والتناغم داخل المدرسة ، وفي علاقتها بخارجيتها. هذه الحقيقة المرة تكشف أن المدرسة ليست في واقع الأمر سوى بناية معزولة عن مطالب التنمية بكل شروطها، كما أنها غائبة عن راهنيه التطور الحضاري.
وتجدر الإشارة إلى أننا لسنا أمام نمط مدرسي واحد. بحيث تتواجد عندنا المدرسة العمومية، والمدرسة الخصوصية، ومدرسة النخبة . ولا داعي للحديث عن الفرو قات داخل كل نوع من هذه الفضاءات التعليمية . وهذه الحقيقة تجعلنا نعترف للأسف بغياب مشروع مدرسي، مع غياب الوسائل، وضبابية الأهداف، ناهيك عن إشكالية العلاقة بشروط التنمية. وتزداد حدة هذه الإشكالية ، حين نبحث في موقع المدرسة بين وسائل الإعلام ، وعالمية التثاقف المتسارع . ولعل هذه الحقائق التي لا ينكرها إلا جاحد، تثير فينا حمى التساؤل عن مسألتين:
الأولى، احترام مبدأ الفردية عند المتعلم
الثانية، مبدأ الاندمـــاج الاجتماعـــــــي
الحقيقة أن هذه البناية لا تبشر بالقدرة على حل هذه المعضلات، نظرا لعدة أسباب منها:
v ماهو مادي
ضعف التجهيزات أ و غيابها مطلقا . بحيث أن غياب الوسائل المساعدة على إنجاز أنشطة نظرية، أو تطبيقية يجعل عمل المدرس، والتلميذ مجرد مغامرة مجهولة العواقب، خاصة وأن عناصر المنهاج الدراسي ليست سوى ترسانة من المعلومات البعيدة عن التجريب الميداني. وبحكم وجودنا المهني ومرارة همومنا المتزايدة ، فيكفي أن نذكر فقط الحالة المهترئة للسبورة ، وانعدام الكهرباء في كثير من الأحيان ، وحالة العطالة التي تشكو منها الوسائل السمعية – البصرية . وتزداد حدة المرارة إذا نظرنا إلى الأقسام المشققة، والنوافذ الغائبة الحاضرة، والمقاعد التي لم تعد كافية للم أطراف التلميذ المراهق في الثانوي ألتأهيلي.فهذا التلميذ الذي تغيرت ملامحه الجسمية مع سن المراهقة لا زال يجلس على ذات المقعد الذي قضى فيه أولى سنواته في التعليم الأولي حين كان صغير السن ، طري البنية الجسدية. فكيف والحالة هذه أن نطالب بالمر دودية ، وندعي بأن تعليمنا على أحسن مايرام ؟ وكيف ستصل المعرفة إلى المتعلم ، وهو في ظروف نفسية ، وجسدية متعبة؟
v ماهو تقني
مدرستنا غير قادرة على أن تعيش " الهنا" و" الآن" في سيرورة متغيرة ، وتجدد مستمر . وتلميذنا غارق في الطرق التلقينية المكرورة ، والمقررات الشبه ميتة ، وبالتالي يصبح شعار الجودة ،وغيره من الشعارات التي تروج لها الوزارة الوصية،مثل :( الشراكة/ الفاعلية/ الدعم/ الإصلاح/ الجودة/الانفتاح) ليس سوى خطاب حماسي خال من الواقعية، وبعيد عن إكراهات الواقع ، وراهنية المعيش اليومي . إذن يصبح الحديث عن مشروع المدرسة ، وتأهيل الإنسان ضربا من الوهم والهلوسة . والحاصل أن ذلك المتعلم يبقى مجرد إشكال ضائع في رحم عقيم نسميه" مدرسة " التي لم تعد تنتج سوى البطالة واليأس.
v ما هو مؤسسي تنظيمي
من خلال تجربتنا المتواضعة في التعليم الثانوي ألتأهيلي، تبين بالملموس أن الشأن التربوي هو آخر ما تفكر فيه الجهات الرسمية. فقد ندخل إلى إدارة معينة من إدارات الجماعات المحلية أو بعض المصالح التابعة لوزارة ما، أو بناية حكومية غير تعليمية، نلاحظ أنها أخذت حقها من التجهيز والترميم والتأثيث. في حين يترك الفضاء التعليمي لمصيره. إذ تظهر عليه علامات الإهمال، والفقر في التجهيزات، في الوقت الذي دخل فيه العالم المعاصر ما يسمى بحرب التعلم . إن التعلم لم يعد منحصرا في درجة النجاح داخل الفصول، أو اكتساب شهادة مهنية ، بل تحول هذا القطاع إلى بؤرة انشغال المجتمعات المعاصرة ، ورهان حضاريي في زمن العولمة والتكتلات الإقليمية و المؤسسات التجارية و الإعلامية.
ب/ صورة المتعلم
إن الحديث عن المدرسة يدفع بنا إلى إثارة ذلك الذي تعتبره الأدبيات التربوية محور العملية التعليمية- التعلمية ( التلميذ ) باعتباره يشكل مركزية الخطاب المنهاجي، الذي يبنى بدوره على أسس ، و منطلقات علمية مضبوطة. فالمتعلم كائن بشري له بناء مركب من عدة عناصر حددتها قواميس علم النفس في جملة خصائص منها : ( الجهاز العصبي+ الحواس+ الغدد+ العقل+ الدوافع+ الرغبات+ الانفعالات+ الإرث الاجتماعي+ الإرث العائلي…) وإذا كانت هذه العناصر تشكل نسبيا قاسما مشتركا من وجهة النظر المخبرية بين الأفراد ، فإن شخصية المتعلم في بلادنا تتوزعها عناصر أخرى أكثر تعقيدا، وهي: الفقر/ اليأس/ الإحباط/ شبح البطالة/ ضبابية المصير/ الإحساس بالدونية/ التخلف/ وجود إرث من العقد الاجتماعية ، والأسرية ... وتأسيسا على هذه الحقائق، اجتماعيا، وعلميا، ونفسيا، فقد أصبح التحكم داخل المدرسة في المتعلم من الصعوبة بمكان. بمعنى أننا حين نضع هذا المتعلم موضع الدراسة البيداغوجية ، فإن محاولتنا هذه ستصبح ضربا من المغامرة . وأمام هذا الاعتراف بصعوبة ضبط هذه الشخصية ، فإننا لا نملك إلا التساؤل: هل مدرستنا في صورتها الحالية قادرة على خلق الاندماج الاجتماعي ، والتقارب الثقافي ، والإنماء المهاري؟
3/ واقع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ربما كان الدافع إلى إنشاء الأكاديميات هو تحسين النظام التعليمي ، وتشجيع البحث التربوي، وذلك بغية حمل الأطر التربوية على الممارسة الفعلية الناشطة، والمساهمة في تجديد أساليب التعلم ، وحل ما يعلق به من مشاكل. ولعل ذلك التوزيع الجهوي والإقليمي للمراكز الأكاديمية للتربية والتكوين، له ما يبرره على المستوى النظري. بحيث أن طبيعة المناطق الجغرافية، والبشرية، والخصوصيات الاجتماعية، والفكرية تطرح نفسها بإلحاح. ولذلك دعت الحاجة إلى احترام الخصوصية . لكن واقع الحال يبين أن هذا التقسيم كانت تفرضه هواجس أمنية في المقام الأول أكثر من العامل التربوي. والأغرب من هذا أن الكتب المدرسية المقررة، الموزعة قسرا على كل مركز أكاديمي ، أو على منطقة معينة داخل كل مركز، لم يشارك في وضعها أو تأليفها من هم أدرى بهذه المنطقة أو تلك أو على الأقل الفاعلون ميدانيا في الحقل التربوي . وقد يعترض قائل فيقول بأن المؤلفين المثبتة أسماؤهم في الكتب المدرسية، هم من المتخصصين أو الذين لهم علاقة بالتربية. هذه المسألة صحيحة على الورق لكن أغلب الذين سموا بالمؤلفين، نعتبرهم غير قريبين من الشأن التربوي بمعنى من المعاني. لأن معظمهم انقطعت صلته بالقسم منذ مدة، بل منهم من تقادمت معارفه، ولم يبق له من العمل التربوي سوى الاسم الشخصي أو العائلي. وبذلك يكون التأليف أو المشاركة فيه قد تحكمت فيهما ظروف تجارية أو علاقات شخصية إن لم تكن زبونيه أو حزبية. وهنك مسألة أخرى تدعونا إلى البحث في التجربة الأكاديمية من حيث نظامها الداخلي وعلاقتها بالوزارة الوصية ، وحدود اختصاصاتها ، وكيفية تعاملها مع الواقع التعليمي ، وكذا طريقة أجرأتها لعملية الامتحانات التجريبية والجهوية. ولعل الداخل إلى أي مركز أكاديمي سيلاحظ كثرة المكاتب والغرف التي تعلن من الملصقات المثبتة على أبوابها، على ترسانة من العناوين والأسماء المغرية للمصالح المتعددة، والتي بخيل إلينا أنها خلية نشيطة في الداخل تتهيأ لإخراج كنوزها . لكن الواقع يؤكد طابع السكونية ، وعقم المبادرة ، وروتينية الخطابات، وكثرة المذكرات المتناقضة في المحتوى والزمن والوظيفة . ثم إن المراكز الأكاديمية تبقى غائبة من الواقع التعليمي وهموم المؤسسات، ولا تتحرك إلا في المواسم المرتبطة بإجراء الامتحانات أو بزيارة مسئول من الوزارة، أو عند صدور قرار وزاري بتنظيم منتدى أو ملتقى معين.. فأين الأسابيع والأيام الثقافية ؟ وأين الأبواب المفتوحة؟ وأين مبدأ الشراكة بين المراكز الأكاديمية ومؤسسات التكوين والتعليم؟ وأين التنشيط والبحث والزيارات الميدانية لإنعاش المحيط التعليمي؟ إن المسألة التربوية غائبة منسية، كما هو الشأن عند وسائل الإعلام والأحزاب والنقابات. وهكذا تحولت الأكاديمية إلى إدارة عادية ومكاتب تشكو غياب المبادرة والتغيير والتجديد. وتحولت المؤسسات التعليمية إلى أقسام يختبئ فيها التلميذ والمدرس إلى حين أن يرن جرس الخروج .كل غارق في همومه الخاصة . وحتى أكون أمينا في توضيح هذه الحقيقة ، أورد بالحرف ما قاله أحد التلاميذ الذين حضروا المنتدى المحلي للإصلاح ، والدي كان يتمحور حول الشراكة ( مايو 2006):" لقد بدأت أفقد شهية الدراسة ، لأنني لم أجد في المؤسسة ما يشبع رغباتي المعرفية . إنني أحس أن المدرس متذمر، تعبر حركاته وملامحه، و طريقة تقديمه للمعرفة عن اليأس والإحباط من الواقع التعليمي، رغم تظاهره بعكس ذلك.لم أجد في المجال المدرسي ما ينمي مواهبي في الأنشطة الموازية...". قد يقول قائل بأن العيب في المؤسسة، والمدرس. نعم صحيح، ولكن هذه المؤسسة ليست سوى نموذج للواقع التعليمي ككل. وهذا المدرس الذي أنهكته روتينية المذكرات والشعارات المحمولة في خطاب الوزارة، وغياب الإرادة الرسمية في معالجة الخلل، لم يقدر على إخفاء تذمره. ( فالمؤسسة لم تعد فضاء مناسبا، والعنف المسكوت عنه ضد رجال التعليم، والمقررات المبتورة، وسوء التسيير والتدبير، ولا مبالاة الجهات المعنية، وغياب دورات تكوينية ، كل ذلك ساهم في هذا الإحساس القاتم لدى المدرس والتلميذ معا).
إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعيش فقرا في الإنتاج التربوي وقطيعة واضحة مع هيئة التدريس ، ومع التلميذ. وهذا الفراغ ترك آثارا سلبية واضحة على المؤسسة التعليمية . وأعتقد أنه لا حاجة بأن أذكر بشيوع ظاهرة التعثر الدراسي والانقطاع عن الدراسة بشكل عام، وانتشارا لغش في الامتحان. هذا الغش الذي يحسبه التلميذ من محاسن المراكز الجهوية للتربية والتكوين ، ومن ورائها وزارة التربية الوطنية. فأمام سرعة التطور واتساع السوق المعرفية، زادت الحاجة إلى تجديد فلسفة التعلم. فأمريكا مثلا ربطت التعلم بأمنها القومي وبسياسة الهيمنة على الآخر . وبذلك اختارت أن تحارب على واجهتين: حرب التعلم وحرب السيطرة. ولا داعي بأن نشير إلى مايسمى بالجامعات المفتوحة في أوروبا ، وجامعة الهواء في اليابان التي تضع أحدث الوسائل التواصلية رهن مطالب السياسة التعليمية، وسنغفورة التي وضعت ما يسمى بأسس مجتمع التعلم الحق ، وفي جنوب أفريقيا سطر برنامج كبير لتعليم الكبار ( انظر مجلة عالم المعرفة: الفجوة الرقمية . عدد318/2005)
أمام هذه السياسات التعليمية التي راهنت عليها مجموعة من الدول ، سواء منها النامية أو المتقدمة ، نجد أنفسنا في بلادنا أمام ما يمكن تسميته بعبثية التمدرس، وفي أحسن الأحوال ، موسمية المعرفة . لأن مناهجنا الدراسية تبنى على العشوائية والانفعال والموسمية والتهافت التجاري على مستوى التأليف وانتقاء الكتب المدرسية . وواضح أن هذه الوضعية تطرح علامات استفهام كثيرة حول
نوع المعرفة المقدمة في المدرسة
نوع التعامل مع الإكراهانت الحضارية، والحقائق العلميةالمتسارعة
إشكالية الأدلجة الثقافية المهيمنة
عملية تعليب المتعلمين وفق مقاس متجاوز
هشاشة التكوين في المدرسة والجامعة والمراكز التربوية
مبررات انتقاء الكتب المدرسية
طبيعة وثقافة ومصداقية من يسمون بالمؤلفين، وواضعي البرامج
انتشار سوق الساعات الإضافية التي أضرت كثيرا بمصداقية المؤسسة العمومية
دخول عملية تأليف الكتاب المدرسي إلى مزاد التهافت المادي
4/ المعــرفـة المقــدمـة كسـؤال إشكـــــــالي
إن نقل المعرفة وتحسينها أمر مرتبط بآليات التأطير والتدبير. فأي تدبير معرفي يمكن الحديث عنه في ظل مؤسسة مهترئة، تقادمت أدواتها ، وأطر تربوية صدئت أسلحتها ، وسياسة تعليمية مسكونة باللامبالاة؟ ثم ماهو أفق تحديث المعرفة ، وخلق عنصر الجودة والمر دودية؟ هذا السؤال المزدوج يثير فينا فضول النبش في جملة من القضايا:
ü طريقة إدارة المؤسسات التعليمية
ü وجود فراغ عقلاني على مستوى خلق ثقافة تشاركيه متصالحة مع الذات والمجتمع والآخر
ü هيمنة النزعة التواكلية، واتساع رقعة التباعد بين النيابة والأكاديمية والوزارة
ü استمرار ثقافة الزبونية والمحسوبية والانتماءات الحزبية
ü استمرار الغموض في العلاقة بين أطراف العملية التعليمية التعلمية
ü إفراغ مجالس التدبير من محتواها ، وانشغالها بأمور خارج تربوية ، وغياب مشاريع تشاركية من أجل التجديد الفكري والثقافي والمعرفي عموما
ü انشغال النيابة والأكاديمية بتغيير جدرانها طوال السنة دون الالتفات إلى مصلحة الجيل المتعلم الغارق في الخصاص على مستوى الأجهزة وأدوات التعلم
ü غياب برنامج واضح لدى الجهازين الأكاديمي والنيابي لتنظيم ندوات، ودورات تكوينية يمكن أن يستفيد منها المعلم والمتعلم.فإذا كانت عملية بناء الشخصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في جميع بنيات النظام التربوي، فإن هذه العملية تقتضي الانطلاق من خطة محكمة تراعي خصوصية المجتمع ومقوماته السوسيو ثقافية.، وكذلك حجم وطبيعة الحاجات الملحة، وبالتالي يصبح من الضروري تعيين الحاجات التربوية وتنظيمها ، تم وضع تصور واضح لوضعيات تقويمية ملائمة ومعلوم أن شخصية المتعلم عندنا مثقلة بحمولة من الإحباطات، والكراهية للمدرسة . وهذه الحقيقة تفضح ضبابية السياسة التعليمية ، وتؤكد أن هناك إجهاضا في حق الحياة المدرسية . وبذلك تبقى تلك الشعارات التي تدعي الحداثة والموضوية ، وما رافقها من مصطلحات براقة، ومثقلة بالحماسة، مجرد خطاب يبررا لأزمة بطريقة خاصة. إن كل تلك المصطلحات البراقـة تزرع في أ رض موات. وغير خاف أن نظامنا التعليمي لا يعكس ما يعج به المجتمع من تناقضات ، كما لم يساير المنافسة الثقافية في عالم أصبح فيه الابتكار العلمي ، وصراع الهوية أحد مكونات البقاء، أو الذوبان في وحشية ثقافة التعولم الرهيبة . وحتى أكون عمليا في هذه الملا حظة، أستعرض أمام القارئ بعضا من الأنماط الحياتية المسكوت عنها في نظامنا التعليمي، أو على الأقل المؤجلة إلى أجل غير مسمى، وهي:
1) سوء التغذية
2) الدعارة
3) عالم الانحراف
4) التفاوت الطبقي
5) مشكلة الإسكان
6) شبح الفقر
7) مشكلة الهجرة ، أوالانتحار نحو الغرب
8) البطالة المقنعة
أما نوع المعرفة المقدمة ، فنجدها كالتالي
1 ) معرفة موسمية
2 ) معرفة متآكلة
3 ) معرفة غير وظيفية
4 ) معرفة براكماتية. معرفة من أجل الامتحان لا غير
وكل هذه المعارف تعجن في شهادة تقديرية ( علمية) لاتسمن ولا تغني من جوع.
ومعلوم أن التربية عملية نمائية في السلوك والمعرفة وبناء الشخصية نفسيا / فكريا/ عاطفيا/ اجتماعيا وبذلك يجب أن ينظر إلى المعرفة كمشروع حضاري مواز لتلك الاختيارات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة . ولكن يبقى السؤال المعلق هو : إلى أي مدى وقع احترام شروط التعلم كحق إنساني وهدف حضاري؟
5 /العلاقة الصدامية بين المدرس/ / التلميذ/ الإدارة/ الآباء
من أهم مقومات نجاح عملية التعلم مبدأ الشراكة والانفتاح، والتسامح، وقبول حق الاختلاف. لكن الوضع المدرسي خصوصا ، والتعليمي على العموم ينضح بالصراعات المجانية التي أفسدت محاولات التعلم . وبالتالي حولت الفضاء المدرسي إلى حلبة للصراع واللاتفاهم.
أ- التلميذ
كائن يعاني حالات الإحباط النفسي ( قلق/ رفض/ عزوف/ يأس/ تهميش/ فقر/ تشاؤم/ ). ومن الطبيعي أن تتولد لديه ردود فعل مشاكسة أحيانا وانتقامية أحيانا أخرى، وفي أغلب الأوقات يصبح كائنا عدوانيا بامتياز. وهكذا يلجأ إلى السلوكات التالية:
توظيف لغة نابية، لا أخلاقية يكسربها نظام القسم ، سواء في حديثه مع زملائه، أو مع مدرسيه، بل يتخذ من القسم ساحة لممارسة العدوانية والرفض و التمرد على الأخلاق.
القيام بحركات جسدية غريبة فطريقة دخوله للقسم، أو في جلوسه على الطاولة، وأثناء استدعائه للسبورة. بحيث تصبح لغة الجسد خطابا جديدا يحمل كل أشكال اللامبالاة والاستهتار.
الكتابة على الجدران والمقاعد، وذلك بتوظيفه كلمات وجمل ساخرة، تتراوح بين السب والذم والقذف أحيانا بأقبح النعوت، وكثيرا ما تكون هذه الكتابة القد حية ضد المدرس والإدارة والوزارة، والدولة أحيانا. فكثيرا ما نلاحظ كتابات مثل: الهروب/ حمام النساء/ قسم للبيع/ قسم للولادة/ وزارة التخريب/ الهجرة إلى أوروبا/...
اللجوء إلى رسم صور مضحكة ومقززة ، القصد منها الإساءة إلى شخص المدير ، أوالحارس العام، أو الأستاذ، وأحيانا يرسم أعضاء تناسلية، ضدا على كل الأخلاق والمواضعات الاجتماعية
هذه السلوكات تجعل الحوار مع التلميذ صعبا، لأنه متشبع بعقلية يائسة ، وعدوانية.وحتى أن تيسر الحوار معه في حصة معينة أو خارج القسم فإنه يحكم على كل الأطراف بالتسلط والإقصاء وعدم فهم مطالبه وحاجاته . أما المؤسسة فهي في نظره سجن اختياري، وفي أحسن الأحوال، مكان لإضاعة الوقت إلى أجل غير مسمى. ولذلك فهو يلجا إلى إتلاف الأجهزة المدرسية لإثبات ذاته ، ورفض ماهو كائن. وأحسن فرصة عنده لممارسة التعنت والانتقام، هو الغش، وبصريح العبارة، غير مكترث بعواقب ذلك.أما المقرر الدراسي، فيعتبره مجرد معرفة عبثية لن تحقق له طموحاته. وهو يتعامل مع المقررات لإنجاز الفروض فقط، وليس لاكتساب الخبرة، أو المهارة وتبقى الإدارة أكبر عدو له. فهي في نظره متحجرة/ تقليدية/ غير متفهمة/ منحازة/ قاسية/ ومعرقلة لرغباته. وعليه، فإنه يبحث دائما عن أسباب التصادم معها.
هذه التصرفات رغم ما فيها من تهور وعدوانية، فإنها تعطينا صورة واضحة عن جملة من العيوب في نظامنا التعليمي، وسوء تصرف الجهاز الإداري، والتربوي عموما مع التلميذ. فقد يكون المدرس أحد الأسباب، لأنه منغلق أو غير مرن، وغير مستمع لمشاكل تلميذه. وقد تكون الإدارة لا توفر شروط الاندماج مع محيط المدرسة، ومنحازة إلى التمييز والتصنيف، وبذلك تكون أول الأسباب في عدوانية التلميذ.
ب/ المـــــــدرس
يعيش انفصاما بين الواجب المهني وأشكال الإجهاض الذي تتعرض له جهوده التعليمية، والتي لا مكان لها في قاموس الجهات الرسمية. فيتحول بمرور الزمن إلى شخصية مقنعة تجري مع الوقت لإتمام البرنامج بأي طريقة ، ولو على حساب المر دودية ، خاصة وانه يرى في الجهاز الإداري ترسانة من المذكرات والقرارات القسرية التي لا تراعي مبد أ التعلم بمعناه الصحيح. ولعل كثرة الأساتذة الذين غادروا القسم ، واختاروا الإدارة ، أو المغادرة الطوعية، خير دليل على البؤس النفسي والإرهاق الجسدي ، والعبثية التي باتت تلازم الممارسة الصفية.
ج/ الإدارة
أضحت مسكونة بالملل في غياب التواصل الشفاف مع المدرس والتلميذ . كما تكتفي بكثرة الاجتماعات المكرورة ، والموسمية ، والتقارير المثقلة بالإحصائيات وملفات الغياب . فأصبحت بذلك عائقا بشكل غير مباشر. ثم إن أغلب عناصر الإدارة المدرسية لم يخضعوا للتكوين، ولا يعرفون أخلاقيات التسيير الإداري. هكذا تتعدد صور التعارض بين الإدارة وهيئة التدريس، كما هو ملاحظ في كثير من الملتقيات والمنتديات والمداولات ، وعمليات إجراء الامتحانات الجهوية والوطنية.
6/ حرب التعلم
تسعى السياسات التعليمية المعاصرة إلى جعل التعلم قضية وطنية وقومية. فالتعلم كما تقول الحكمة الصينية أشبه بعملية الزراعة. لأن حصاد النتائج مرتبط بعملية الزرع وطريقة استنباته وعمليات الرعاية والتتبع. فالتنمية الاقتصادية والثقافية والفكرية والبشرية رهينة بالتعلم كواجب في المقام الأول وحق لا مناص منه. وانطلاقا من هذه الحقيقة، لم يعد ينظر إلى التعلم كموسم ثقافي أو نزوة معرفية، أو شعار إيديولوجي. إنه سمة إنسانية تحقق للمتعلم إنسانيته، وتعيد للعقل حيويته. وعلى هذا الأساس أصبحت برامج التعلم وتقنياته أشبه بحرب حضارية في زمن الانفجار المعرفي والسكاني، وتكنولوجيا الاتصال والتواصل. وبهذا المعنى، فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية العمومية ماديا وبشريا ومعنويا.، ومحاربة كل أشكال الهدر المدرسي في أبعاده النفسية والمادية والفكرية ، دون إغفال عملية تنمية وتشجيع البحث التربوي، والارتقاء بقيم التعامل داخل النظام التربوي ، ومع محيطه . ومن المعلوم أن كسب رهان التعلم يقوم على جملة من الاختيارات. وأركز فقط على ثلاثة نماذج : خيار التكنولوجيا وخيار الشراكة، وحقوق الإنسان. وهي من بين الشعارات التي لوحت بها وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة .
v الشراكة
إن مفهوم الشراكة في المجال التربوي عبارة عن إسهام فعال ، ونماء متواصل لأطراف فاعلين من داخل المحيط المدرسي أو مع خارجه. والشراكة بهذا المعنى سير إلى طريق التضامن ، والتلاحم ، بهدف تحقيق عنصر الجودة ، وتحسين المر دودية . بيد أن التلويح بالشراكة لا يعني التملص من التعليم كمسئولية وطنية كبرى على عاتق الدولة . بحيث أن مجرد التفكير في ضرب مجانية التعليم ، أو الدفع به إلى متاهات الخوصصة ن سيؤدي إلى كارثة اجتماعية .، كما سيوسع الهوة بين التعليم النخبوي والشعبي ، ويشيع ظاهرة التمييز . وعلى هذا الأساس لا بد من إشاعة مفهوم الشراكة كثقافة وطنية مبنية على التضامن والتطوع ، وحب المنفعة العامة ، وليس المراهنة على عقلية تجارية مريضة بحسابات الربح والخسارة . فما أكثر الشركاء ، ولكن المشكلة في نوعية الشريك ، وفي مضامين الشراكة ، والأهداف منها. فمن هو الشريك النافع لقطاع التعليم؟ وما هي طريقة التعامل معه؟ وما هي درجة وعي الشريك بأن المؤسسة التعليمية لها أولوية الاستفادة كواجب وطني ، وليس النظر إليها كمؤسسة متسولة؟
v تكنولوجيا الاتصال والتواصل
صحيح أن هناك علاقة قوية بين المنظومة التربوية وما هو تكنولوجي ، ثم إن المجال التربوي يتقاطع مع البنى الثقافية المتسارعة . فقد أصبحت التكنولوجيا ثقافة مهيمنة، خصوصا بعدما تزايد حجم الدعوة إلى تكامل المعرفة. ولذلك ظهر ذلك الطابع التبادلي لعلاقة تكنولوجيا الإعلام بالممارسة التربوية. فقد لوحظ أن سرعة التطور التكنولوجي بدأت تطرح تخوفات من عدم قدرة المجتمع الإنساني على استيعابها. فلم يعد الاهتمام التربوي محصورا في الكم المعرفي الصرف، ولكن تولد التفكير في تأسيس معرفة تكنولوجية. غير أن تحقيق هذه الغاية يجب أن يتأسس على حقائق بشرية ومادية وتقنية ،حتى لا يبقى الحديث عن هذا الموضوع مجرد موضة وقتية ، وتهافت فرجوي ن بقدر ما هو إلحاف نحو التتبع والممارسة .
وإذا كنا نروم تعليم التلميذ مبادئ فكر وثقافة التكنولوجيا، فإن المنطق العلمي يدعو إلى التفكير في العناصر الداخلية للمنظومة التكنولوجية. فهذه الثقافة المتعلمنة لهـا فئات نتعامــل معهــا : (إعلاميون/ مبدعون/ نقاد/ مهندسون/ فنانون/ تربويون/ علماء النفس/ اقتصاديون/ علماء اللغة...)، كما أنها محاطة بنظم فكرية متعددة: ( تقنية/ فلسفية/ هندسية/ رياضيات/ تشكيل/...)
وهذا التعدد في الاختصاص والفروع يفرض علينا تحديد الملامح العامة التي نريدها في البرنامج التعليمي. هل يكفي النظر والحالة هذه إلى هذه التقنية كمادة دراسية جافة في استعمالات الزمن عند التلاميذ؟أم نضع لها تصورا ديداكتيكيا مضبوطا؟ وغير خاف أن تكنولوجيا الإعلام والتواصل ذات أبعاد اجتماعية ، واقتصادية ، وصناعية ، ومعلوماتية، ونفسية ، ومخبرية، وكل ما يرتبط بذلك من تدبير وتسيير وتواصل وإبداعية بحثة.
واسترشادا بما سبق، فإن المدرسة تبقى جديرة بأن تؤهل وتنظم ، وتتغير في وظيفتها من التقليدية والتحجر إلى الانفتاح على العتاد المعرفي الجديد . وبذلك سيتحقق الحد الأدنى على الأقل من الأهداف والكفايات المنشودة . من ذلك
القدرة على التواصل مع أدوات تقنية معقدة
توظيف المعرفة المكتسبة تكنولوجيا في مختلف الوضعيات العلمية
اكتساب مهارة التدبير والتسيير وحل المشكلات
اكتساب آليات الخطاب التكنولوجي بالرمز أو بالصورة أو غيرهما
امتلاك القدرة على التجريب والمغامرة غير المحدودة
التخلص من نزعة الانبهار والتفرج ، إلى روح المبادرة
الإيمان بأهمية الابتكار ، والتخلص من عادة العطالة الفكرية
اعتبار الفضاء التكنولوجي وسيلة لفهم الحياة، وتجاوزا لمشكلات الطارئة والمستجدة.
v حقوق الإنسان
هي قوانين و علاقات فوق الدولة . وهي نوعان: عامة وخاصة. ولقد فصل القانون في مجموعة من الحقوق السياسية والحزبية و النقابية والجمعوية ، وغيرها من عناصر تتعلق بالعلاقات الاجتماعية. والقانون عموما هو مجموعة قواعد تنظم العلاقة بين طرفين أو أكثر . أما النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ، فقد طرحت ما يشبه ( نظرية حقوق الإنسان) لمحاربة كل أشكال الاستعباد و الاسترقاء والحروب . وهنا طرح هذا السؤال الكبير: من المسئول عن حقوق الإنسان ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ، يمكن الاطلاع على الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية .
إن الحقل القانوني، والعلم بفروعه البيولوجية والنفسية والسوسيولوجية وغيرها من العلوم المتصلة بالإنسان، تؤكد على تداخل الحقوق البدنية والفكرية والنفسية . بحيث تنظر إلى الإنسان ككيان آدمي وكينونة حتمية يجب احترام آلياتها وعناصر تواجدها وحماية بقائها. أما الشرع فهو واضح على ضوء نصوص القرآن والسنة. إذ وردت مصطلحات كثيرة مثل التكريم، السلم، المساواة، العدل...الخ
و لابد في اعتقادنا من تحديد بعض المصطلحات المرتبطة بالحقوق حتى تستوضح الصورة أكثر
أ/ مفهوم الحقوق: هي مجموعة من الامتيازات المتأصلة في الإنسان، والتي تميزه عن باقي المخلوقات . وتضمن له حق الاحترام والتكريم والحماية . أما العناصر التي تنتفع بالحقوق داخل الكيان البشري، فهي: الجسد/ الفكر/ الروح. وكل واحد من هذه العناصر يتفرع إلى مجموعة من المكونات تتداخل فيما بينها بشكل بنيوي . وبالإضافة إلى هذه الحقوق الفردية والجماعية وكل ما يتعلق بالهيئات والجمعيات، هناك حقوق تتعلق بالشعوب. كحق الشعوب الفقيرة المستعمرة في استغلال ثرواتها واختيار مستقبلها السياسي والوطني، واستقلالها الاقتصادي والفكري.( وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لم يحدث فيها لحد الآن أي اتفاق دولي )
ب/ حقوق الراشد: يصعب حصر نوع وطبيعة هذه الحقوق.لكن يمكن تصنيفها إلى حقوق سياسية ومدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية. وكل صنف له قيم حقوقية مثل: الحرية/ المساواة/ الكرامة/ الديمقراطية/ العدالة / التعبير / التجمع / التظاهر/ النقد... بيد أن هذه الحقوق لاتعني التسيب. ولكنها فكر ومنهج، واقتناع واع بالجمع بين الحق والواجب .
ج/ حقوق الطفل: حين نتكلم عن حقوق الطفل، نلاحظ أن حقوقه تفوق حقوق الراشد كما ونوعا. وذلك لعدة أسباب .ومن أجل توضيح الطبيعة القيمية العليا لهذا الكائن، لا بد من ذكر المحددات الفيزيولوجية والقانونية والشرعية للطفل. فهو يعرف من الناحية الفيزيولوجية من 0 إلى 18 سنة. وهذه المساحة العمرية لها مبرراتها نفسيا وبدنيا ووجدانيا. فهو كائن هش يحتاج إلى حقوق. وهنا ظهر قانونيا ما يسمى بالمصلحة الفضلى . وهي تلك الحقوق الإضافية والأساليب التي تهيج وتحفز نموه الوجداني. ثم إنه إنسان قبل كل شيء له حقوق في الاسم والحياة والصحة والنماء والبقاء. ولذلك رفعت دعوات إلى تأهيل هذه الحقوق لينتقل القانون من الدفاع عن حقوق الطفل إلى حقوق مرتبطة بالرفاهية . وتبقى هذه الحقوق ذات بعد إنساني. من هذا المنطلق ، نطرح السؤال التالي : ماهي الجهات المسئولة عن حقوق الإنسان؟
إنها الأسرة و المدرسة و المجتمع و الدولة. غير أن هذه الجهات تكون أحيانا عاملا في إجهاض تلك الحقوق. وللإشارة إلى المعيقات ، سنجد في المناهج التربوية ، وفي المدرسة ما بثبت ذلك.
المعيقات المادية: وتتجلى في الفقر الذي يدفع الكثيرين إلى بيع الكرامة. وهذه المعضلة يصعب حلها في غياب مشروع تنموي وتربوي.
المعيقات الذاتية: وهي تلك النظرة الدونية إلى الذات والإحساس بالنقص والهامشية . بل هناك من تعود على الكبت الإرادي وتمجيد الآخر على حساب كينونته الخاصة. بحيث لا زالت النظرة إلى أنواع معينة من اللباس السلطوي أو الطبقي تخيف الكثيرين بشكل غرائبي متجدر.
المعيقات في المجال التربوي:
وتبدأ بالمناهج التي قد تؤسس فصلا آخر من فصول هدر الكرامة، وترويج ثقافة الخوف والصمت ، والانطوائية، وتمجيد ما هو كائن دون نقد أو احتجاج.هذه العوامل وغيرها تعتبر ألغاما مزروعة وحدودا فاصلة تحجب الحقيقة ، وتبطل الواجب ويمكن أن نذكر معيقات أخرى كالأسرة ، وبعض الأطر التربوية التي تنقل عقدها ومشاكلها إلى الفضاء المدرسي.
7/ علاقة الفضاء التربوي بحقوق الإنسان
التربية في أبسط تعار يفها هي نقل الخبرات والتجارب من جيل سابق إلى جيل لاحق. وهي في نهاية المطاف سعي نحو التغيير في السلوك والفكر والممارسة . ومن هذا المنطلق نعتبر الفضاء المدرسي مجالا واسعا للتربية على حقوق الإنسان. لكن هل واقع المؤسسات التعليمية يسمح بإشاعة تلك القيم الإنسانية المرتبطة بالحقوق؟
الإجابة على هذا التساؤل ستدخلنا في نفق تتعدد مساربه ، والتواءاته. فالحياة المدرسية تتداخل فيها كثلة من الطاقات البشرية ، وترسانة من القوانين و المذكرات التنظيمية . وإذا ألقينا نظرة على طبيعة المتدخلين في الشأن المدرسي ن نلاحظ ذلك التناقض الكبير بين ما هو كائن، وما يجب أن يكون. ويمكن أن نشير على سبيل المثال إلى نماذج من المعيقات للحقوق الإنسانية في الحياة المدرسية.
“ الاكتظاظ :
تضيع معه حقوق التلميذ إضافة إلى غياب أبسط الضروريات الترفيهية والتثقيفية والصحية
“ طبيعة المناهج الدراسية:
فارغة في محتواها ، المرهقة في موضوعاتها ، والداعية إلى الاستكانة والخضوع واليأس، والعبثية أحيانا. كما أنها غير مرتبطة بهموم التلميذ، وبإكراهات الواقع
“ طرق التدريس:
مبنية على التلقين، والتصادم، وغياب الثقة، والكراهية أحيانا.
“ شروط العمل داخل المؤسسة:
عدم الإحساس بالراحة النفسية، وكثرة عوامل الكراهية والنفور. باختصار،غياب الحوافز وأسباب تحبيب المدرسة والتمدرس.
“ أنظمة الامتحانات:
مبنية على الموسمية والإقصاء والعشوائ
ماذا قدم المنهاج للمتعلم والمدرس والمجتمع؟
يجب الاعتراف أولا بوجود أشياء كثيرة مهمشة داخل المنهاج الدراسي ببلادنا. كما أن الظروف المادية والنفسية التي يشتغل في إطارها المدرس لا تسمح له بأن يلتزم حرفيا بالتعليمات الرسمية وشبه الرسمية. وهنا يتأجج داخلنا الشعور بالحاجة إلى التساؤل :
· ما نوع التعلم الذي نريده للمتمدرس؟
· ما نوع التعلم الذي تلقاه المدرس؟ وما هي طبيعة تكوينه التربوي؟
· ما نوع التنشئة الاجتماعية والمهنية للمدرس والمتعلم؟
· ما هو حجم الإمكانات والوسائل المتاحة لانجاز المهام الدراسية؟
والملاحظ أن سياساتنا التربوية لم تكن تأخذ بعين الاعتبار الشروط الحقيقية لتنفيذ المشروع الدراسي. كما أن المنهاج عندنا لا يعكس بصدق ما يعج به المجتمع، وما تتطلبه ظروف المنافسة الثقافية والحضارية في عالم أصبح فيه الابتكار العلمي وصراع الهوية احد مكونات البقاء أو الذوبان الحضاري. وانطلاقا من تجربتنا المتواضعة في الحقل التربوي نلاحظ ذلك الغياب الرهيب للخصوصيات التي ينفرد بها المجتمع المغربي. ذلك أن مشاريعنا التعليمية تسكت عن مجموعة حقائق معيشة، وتكتفي بإظهار ذلك الوجه المقنع للمجتمع. في حين يقع التغافل عن أنماط حياتية لدى شرائح واسعة. ومن جملة ما يسكت عنه المنهاج:
1. أزمة الشغل
2. اتساع الهوة بين المدرسة وإكراهات الواقع
3. انحراف المتمدرسين
4. ازدياد مظاهرالنفورمن المدرسة
5. تراجع ثقة الآباء و الأمهات في التعليم العمومي
6. عدم قدرة المدرسة على إشباع حاجات المتعلم
7. إشكالية الفقر
8. الهروبية إلى عوالم غرائبية دون مراعاة الضوابط الأخلاقية والدينية والاجتماعية
وإذا حاولنا في عجالة حصر ما قدمه المنهاج لأطراف العملية التعليمية التعلمية، فإننا نصطدم بالحقائق الآتية:
أ. بالنسبة للمتعلم
يؤكد الواقع التعليمي عندنا أن المتعلم قد فقد استقراره النفسي بسبب حالات القلق الضجر، العزوف ، الخوف. فتحول سلوكه من الفضول المعرفي إلى العدوانية أحيانا والانطوائية أحيانا أخرى. وفي كلتا الحالتين يتولد عنده إحساس قاتم بعبثية التمدرس. فتكون الحصيلة انه يؤسس لنفسه معرفة خاصة به. وبالمقابل يرفض كل معرفة تأتيه من المدرس أو المادة أو الإدارة.
ب. بالنسبة للمدرس
أصبح شخصا سلبيا يتصنع في كثير من الأحيان. لأنه يعرف مسبقا عدم جدوى ما يقدمه للتلاميذ. ثم انه يحاول جهد الإمكان إتمام الوحدة الدراسية في وقت معين دون التفكير في المر دودية. فتغيب بالتالي حوافز الممارسة البيداغوجية، وتنعدم روح التغيير والابتكار. كما يقع الاكتفاء بتيني موقف سلبي من المادة والتلميذ والمؤسسة. وهذه المواقف تؤثر في علاقته بجماعة القسم، وبطريقة تقديمه للمادة ، وفي خطابه وحركاته وملامح وجهه.
جـ. بالنسبة للمجتمع
يعطينا ذلك المشروع الدراسي الذي وصفناه سابقا تلاميذ معاقين فكريا. لان غياب التوافق بين قيم المدرسة والقيم الخارج مدرسية يؤدي إلى تقاطع حاد بين ذلك التصور المثالي للمجتمع والفرد الذي تلفظه المدرسة. ولعل شيوع ظاهرة التسكع في أوساط الشباب تؤكد سلبية نظامنا التعليمي وعدم جدوى التنشئة المدرسية والاجتماعية. وتبقى النتيجة هي أن الفقر الفكري يتناسل مع الفقر الاجتماعي. الشيء الذي ينتج كل أشكال الانفصام الذاتي والكبت الإرادي.
خـــــــــلاصـــــــــة
لقد أصبحت الحاجة إلى تجديد المعرفة مسألة ضرورية ، لكي تتضح ملامح البيداغوجيا الهادفـة
التي تراهن على المتعلم باعتباره الرأسمال الحقيقي في بناء المجتمع. وهذا الطموح مرتبط بالإصلاح والتغيير، والتكوين، وإعادة التكوين. وأما الإصلاح ، فهو مسألة موكولة للدولة ، وبمساعدة ومباركة المجتمع ، وأما التغييرفهو ضرورة اجتماعية وفكرية وأخلاقية. وأما التكوين، فلا بد له من تخطيط ممنهج يساير التطور العلمي ، وحاجة السوق الثقافية العالمية . أما بالنسبة لإعادة التكوين فلنا فيها وجهة نظر تتلخص في:
ü تحديد نوع وحجم وطبيعة التكوين
ü رسم أهداف التكوين
ü تحديد الحاجيات والفئة المستهدفة
ü وضع اختيار منهجي يضبط عملية وطريقة وأدوات التكوين
ü نوعية القائمين على التكوين ومستواهم المهني أو الاحترافي
فإذا كانت هذه المطالب تتجاوز اختصاصي كمدرس باعتبارها موكولة إلى هيئة تنظيمية ذات مسطرة إدارية وقانونية، ومالية ، فإنها تعطيني الحق كمرب في طرح بعض الاقتراحات النابعة من همومي المهنية.
فالتكوين المستمر ليس مجرد تجمع بشري موزع إلى خبير مكون ، ناقل للمعرفة ، ومستهدف محتاج إليها ، وإنما هو ورشة عمل تتكامل فيها الخبرة النظرية بالتجربة الميدانية . وبالتالي فالتكوين الصحيح في نظرنا يقوم على:
Š دقة التأطير بأسلوب علمي بعيد عن العشوائية والارتجال
Š تحديد أهداف التكوين وفق الضرورة ، وما قد يطرأ من مفاجآت
Š طرح مستجدات تربوية بعيدة عن موضوية الاستهلاك الآلي للنظريات الأجنبية ، وبدون مبررات
Š الحرص على تغير عقلية المستهدف بالتكوين، بما يتلاءم وروح العصرنة ، وعالمية المثاقفة
Š السعي إلى خلق المدرس الباحث المسكون بالتجريب، وليس المدرس الملقن بشكل آلي ، ومبتسر
أما ما يخص المجال المعرفين أو مادة التكوين، فإنني أرى أن يكون التكوين على مرحلتين:
“ مرحلة التكوين التربوي: ويتجه إلى ثلاثة عناصر:
الجهاز المفاهيمي: وهو ما يتعلق بالتصورات التربوية الفعالة ومستجدات علوم التربية
الهندسة البيداغوجية: كيفية بناء الدروس ، وطريقة التعامل مع التلميذ، وتكييف المحتوى وفق واقع القسم المغربي، وكذا أشكال الاختبارات وما يتبعها من تصحيح ودعم وتقويم
“ مرحلة تعميق التخصص: ونقصد بها:
دفع المدرسين إلى تجديد معارفهم بمادة التخصص
إعادة النظر في تلك الأسلحة المعرفية، أو تكييفها مع الإكراهات الراهنة.


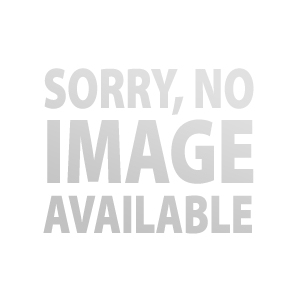
0 التعليقات:
إرسال تعليق